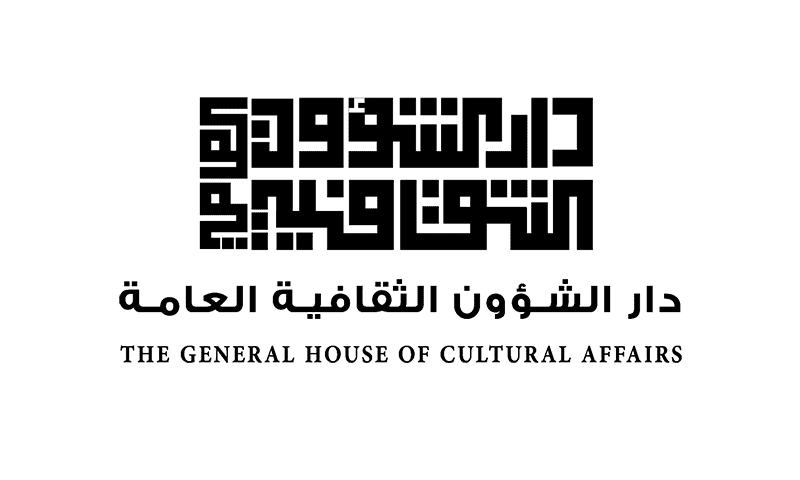دراسات وبحوث
صور من التراث الشعبي في كربلاء
دراسة
صور من التراث الشعبي في كربلاء
أ.د.عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي
جامعة كربلاء
كلية التربية للعلوم الانسانية
اختصت مدينة كربلاء بتراث شعبي واسع يتصل بعمقها الحضاري وثرائها الديني والمعرفي، فكانت بمثابة لوحة يتجلَّى فيها هذا الثراء بألوانه المُمتزجة بطوابع الحياة مُعبِّرة عن فولكلورها في اللبس والأزياء والعادات والتقاليد، وما يرتبط بالمعتقدات الكربلائية مروراً بالأطعمة والأشربة المُبرَّزة في تراث هذه المدينة؛ فكان المُبتغى من هذه الوقفة الاسهام في إلقاء الضوء على جانب من غنى هذا التراث وتنوِّعه اعتماداً على مشارب الكتابة في أرشفة التراث الشعبي الكربلائي على يد سلمان هادي آل طعمة وغيره من المعنيين بتوثيقه في مجلة (التراث الشعبي) منذ عام 1964م .
الملابس والأزياء الشعبية
شكل المجتمع الكربلائي تنوعا متجانسا بمختلف شرائحه، ولذلك يلاحظ أن كل شريحة اتصف ابناؤها بأزياء معينة تعبر عن شخصية تلك الشريحة التي ينتمي إليها، فان الأزياء الكربلائية تبدو وكأنها مجموعة ألوان زاهية تعطي صورة جمالية ربما يمتاز بها الكربلائيون دون غيرهم من سكان المدن العراقية الأخرى، كما إنَّ المجتمع الكربلائي ينظر بنوع من الاحترام للشخص من خلال هندامه ومظهره الخارجي، لأن الكربلائيين بطبيعتهم يدركون إن مظهر الشخص ينبئ إلى حد ما عن طبيعة تفكيره وسلوكه وكان علماء الدين في الموقع الأول في المقام الاجتماعي في كربلاء آنذاك وذلك لمكانتهم التي اعتمدت على كونهم يمثلون مراجع دينية في مجال التوجيه والإرشاد والوعظ والافتاء، ولذا فانهم تميزوا بزي معين يختلف عن الأزياء للفئات الاجتماعية الأخرى، فقد كانوا يرتدون عمامتهم السوداء، فهي تلك التي تشير برأيهم إلى علماء الدين، ممن ينتسبون إلى الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، كما يرتدي العلماء غير المنتمين إلى نسب علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عمامة بيضاء، وقميصًا أبيض في أغلب الأحيان، تغطيه الجبة ( ) أو الصاية ( ) عليها عباءةٌ سوداء أو داكنة على العموم، في حين يتصف التجار بزي خاص يتَّسم بقدر من الطابع الرسمي المنضبط الذي لا بد من الحرص عليه، إذ يتألف الزي من بدلة العمل من جاكيت وبنطلون وقميص، ويمكن أن تكون البدلة سوداء اللون مع استخدام ربطة العنق في بعض الأحيان من أصحاب المهن المدرسية والمكتبية والأدبية( ).
ولعل الاختلاف الأكثر وضوحا في مجال الأزياء يتمثل في التباين ما بين أزياء سكان المدينة وسكان الريف، فالبدو والريفيون بوصفهم فئات اجتماعية لها دور في المجتمع الكربلائي كانوا يرتدون على العموم الثوب الفضفاض الطويل( )، ذا اللون الأبيض، والعقال العربي وما يعرف بـ الغترة أو الشماغ ( ) فضلاً عن ارتداء العباءة العربية التي كانت توضع على أكتاف الرجال( ) في حين تتألف أزياء النساء الريفيات من القمصان العريضة الواسعة الأكمام، وتحتشم المرأة بزيها بارتداء عباءة طويلة تبدأ من الرأس وتنتهي بالقدمين، فضلا عن منديل "الحجاب" مصنوع من القطن تضعه المرأة على رأسها زيادة في التحصين والاحتشام وبعض النساء كن يتحلين بارتداء الأساور والجلاجيل إلى جانب حلقات ذهبية يضعنها في أنوفهن( ).
أما رداء المرأة الكربلائية في داخل المدينة فيتكون من العصابة( )، والفوطة( )، وإزار طويل تعقده المرأة في وسطها، أي قطعة قماش أسود تكون على الأغلب شفافة فيها نقاط سميكة بزخارف جميلة، ترتديها المرأة فوق الثياب في مواسم الحزن كالمآتم، وتكون فضفاضة ويعرف هذا الغطاء بـ "الهاشمي"، في حين تعتمر على رأسها غطاء يكمل زيها، كذلك تضع على وجهها قطعة من القماش يعرف باسم "البوشية"( ).
العادات والتقاليد الشعبية
عُرف المجتمع في كربلاء بعادات وتقاليد اجتماعية حرص عليها، لأنها تعبر عن شخصيته، فاتسمت العائلة عموماً بكثرة إنجاب الأولاد، ويعد الزوج المحور الأساس في العائلة، فهو رب الأسرة سواء كان متزوجًا بامرأة واحدة أم أكثر( )، فضلا عن بقاء أبنائه المتزوجين من الذكور مع بناته غير المتزوجات أو الأرامل والمطلقات ضمن نطاق البيت الواحد( )، ويكون الأب أو الجد المشرف على نشاطات الأسرة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية( )، ويمتلك حق التصرف بشؤون أسرته في الانفاق والمسكن والمأكل ويحميها من الأخطار( )، ولذلك كان أفراد الأسرة جميعهم يطيعون الأب وينفذون أوامره دون مناقشة، لإدراكهم لمكانته ورجاحة عقله وحسن تدبيره في تسيير أمور الأسرة( ).
ولعل من المفيد هنا أن نستشهد بما يقوله الرحال جيمس بيكنغهام عام 1816 عندما زار العراق "منطقة فرات الأوسط" ؛ إذْ لاحظ أهمية الرجل في الأسرة وخاصة احترام المرأة له فقال" في مناسبات عديدة شاهدنا مبلغ عناية الزوجات بأزواجهن ومبلغ الاحترام والخضوع الذي تبديه الزوجة لزوجها وفي الصباح حيث يساعدن أزواجهن في ارتداء الملابس وخلعها والقيام بكل واجبات الوصيف ويؤدي الصلاة يجلس على السجادة بينما تهيئ الزوجة القهوة او الشاي وتقدمها لزوجها بخضوع بالغ وتقف على بعد منه مكتفة الأيدي في بعض الاحيان، وبعد انتهاء الزوج من شرابه يناول زوجته القدح وأحيانا تقبل يده علامة الخضوع والإخلاص التام"( ).
أما مكانة الأبناء ودورهم في الأسرة فانهم يشكلون العناصر الفاعلة في مساعدة الأب اقتصادياً، يعملون في مختلف النشاطات الاقتصادية، لتوفير الإمكانيات المادية للعائلة، وبعد زواجهم تبقى مكانتهم في الأسرة، في حين تبقى البنات الأخريات في داخل الأسرة تحت سيطرة الأب والأخوة، ويمكن القول إن هذا النظام العائلي المنظم ينبع من طبيعة الكربلائي الذي يميل الى حسن العيش من خلال الأخلاقيات التي تسهم في إشاعة أجواء الاطمئنان والارتياح في داخل الأسرة الكربلائية( ).
وفيما يتعلق بالعادات والتقاليد الخاصة بأحوال الشخصية على سبيل المثال لا الحصر "الزواج ومتعلقاته، وولادات الأطفال، وعملية الختان، والمأتم" وغيرها من المناسبات، فأنها ترسم صورة لواقع المجتمع آنذاك، فعلى مستوى مراسيم الزواج كان الكربلائيون يتعمدون اظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة وذلك عن طريق أشاعه الأهازيج والدبكات الاجتماعية، فضلاً عما يرافق زفة العروس الى بيت العريس من مظاهر إطلاق الصيحات "الهوسات" وكانت زفة العروس في عربات تجرها الخيول تسمى الربل وتم استخدام السيارات أيضاً فيما بعد وعند وصولها إلى باب بيت زوجها يذبح لها الخروف على عتبة الباب للبركة، فضلا عن الرقص المتعارف عليه عند الرجال بــ(الـﭽوبي) تعبيرا عن فرحهم وسرورهم( )، التي تجري برفقة عزف الفرق الموسيقية، واعتمد السياق الاجتماعي في المجتمع أصولاً متعارفًا عليها في مراسيم الزواج وخاصة ما يتعلق بتحديد مقدار المهر المتفق عليه بين ذوي العريس والعروسة وغالبًا يتراوح الصداق المؤجل "الغائب" بين عشرين وخمس وثلاثين ديناراً، أما المعجل "الحاضر" فتتراوح قيمته تقريبا بين أربعين وخمسين ديناراً، فضلا عن تقديم الحلي الذهبية لها التي يجري الاتفاق عليها، وبعدها يقرر هذا الاتفاق من خلال إشهار عقد الزواج، والزفاف الذي تسبقه ليلة تعرف في الاوساط الاجتماعية بـ"ليلة الحنة" والتي يحضر إليها الأقرباء من العروس والعريس( )، وعادة يزف الأقارب والأصدقاء العريس الى عروسته بعد صلاة العشاء ويسير الجمع وهم يرددون الأهزوجة الشعبية التي ما زالت تردد في بعض فئات المجتمع: "شايف خير ومستاهلهه"،" ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد"( )، ويلاحظ في مضمون هذه الأهزوجة التي ترافق الزواج عند أهالي كربلاء ، تشير الى كونها عرفاً اجتماعيًا يعود الى حقب طويلة، ومنها الحقبة العثمانية، ولذلك أتخذه الكربلائيون منطلقا لأهازيجهم.
وفي مقابل فعالية زف العروس، فان العروسة هي الأخرى تحظى باحترام اجتماعي في مراسيم الزفاف، إذ حرص الكربلائيون على حرمتها من خلال غطائها الذي يبدأ من رأسها الى قدميها، وفي ذلك مؤشر على مقدار تمسك أهالي كربلاء بعفاف المرأة لان اللون الأبيض الذي تتوشح به العروسة كان يدل على نقاء شرفها وعفتها، وتجدر الإشارة الى إن جدة العروسة او عمتها تصحبها الى دار زوجها، وهناك تباين نسبي في مسألة ملابس العروس بين منطقة وأخرى من المناطق التابعة لمدينة كربلاء، فاذا كان أهل المدينة يتخذون الملابس البيضاء للعروسة في زفافها فإن ذلك لا يتنافى مع ارتداء العرائس في المناطق الريفية للون الأحمر؛ ولا تستعمل ملابس العروسة أكثر من أيام معدودة؛ إذْ يتم الاحتفاظ بها ذكرى لتاريخ الزواج، أما ولادة الأطفال فيحتفي الكربلائيون بولادة أطفالهم، ويصاحب ذلك توزيع الصدقات على فقراء المحلة ولاسيما ولادة الطفل الذكر، إذ يشرع والد الطفل بإقامة وليمة لأهالي المحلة، كما كان لرجل الدين دور في هذا المجال إذ يتولى تلقين الأذان في أذن الطفل اليمنى والاقامة بالأذن اليسرى( )، فضلاً عن اعطاء الصدقات للمحتاجين والفقراء وبعدها يسمى الطفل بالأسماء المحببة لدى أهالي كربلاء، وقد يؤخذ المولود الى أحد العلماء أو الفضلاء؛ وذلك ليكبِّر في أذنه ثلاث تكبيرات ثم يقول اسم الطفل، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة المولود في مجال تحصيله الديني من خلال دراسته في المدارس، وتجدر الإشارة الى حرص الأسرة على حث أبنائهم على قراءة القرآن الكريم وختمه، فعندما ينتهي الطفل من ختم القرآن الكريم، تقام لهُ وليمة يدعى إليها الاهالي لبيان المكانة الدينية التي وصل إليها الطفل بعد ختمه القرآن الكريم( ).
وكان الكربلائيون يحتفلون بختان الأطفال أيضاً، إذ تقام بهذه المناسبة حفلة خاصة في بيت والد الطفل المختون وحسب القدرة المادية لرب العائلة، ولكن في كل الاحوال كانت تجري بوصفها تعبيرا عن فعالية اجتماعية يحرصون على إظهارها، وتبدأ مراسيم هذه الحفلة بختان الاطفال في الساعات الأولى من النهار وذلك تجاوزا للحالات التي قد تحصل جراء تأخير عملية الختان وكانت عملية الختان تجرى اما في البيت او المستشفى، وانسجاما مع دعوة رب الأسرة لضيوفه بحضور وجبة فطور صباحية، ويُصاحب ختان الطفل رفع الأصوات بالتهليل والتكبير وتوزيع الواهلية ( ) والصدقات على فقراء المحلة.
أما المآتم (الوفاة) فيتم أخبار الأقارب والأصدقاء بحالة الوفاة، لغرض تشييعه في أحد مساجد المدينة، فإذا صادف مرور التشييع في أحد الأسواق تغلق الحوانيت احتراماً لذلك، وحين يكون التشييع خاصاً بالسادة والعلماء وأبناء الأسر المعروفة في المدينة والوجوه والأعيان، يدعو المؤذن الناس للحضور الى دار الفقيد أو إلى أحد المغتسلات على الوجه الآتي "أخواني المؤمنين: انقلوا اقدامكم الى مغتسل المخيم لتشييع جثمان المرحوم المغفور له السيد فلان بن فلان من آلـ فلان، الحكم لله الواحد القهار"، يكررها ثلاث مرات ( )، وإذا كان المتوفي من شيوخ العشائر فغالباً ما يصاحب تشييعه إطلاق العيارات النارية أو ما يسمى بالعراضة( ).
المرأة الكربلائية
خضعت المرأة منذ العهود السابقة، لنظام الأسرة، فهي في نظر زوجها عماد البيت الذي ومدبرة شؤون المنزل وتربية الأولاد، والقائمة على توفير مستلزمات الراحة والسعادة في البيت، ضمن هذه الرؤية الاجتماعية للمرأة، ولم يكن لها حرية مغادرة الدار الى حد التزمت، ولا بد من الاشارة الى إن للمرأة دورًا في مساندة الرجل اقتصادياً، إذ كانت تعمل في مجال الغزل وتهيئة الاقطان في داخل المنزل، بما يتلاءم مع طبيعة دورها، بوصفها أُمَّا ومُربية وعاملة في آن واحد( ).
أما المرأة في ريف كربلاء فإنَّها كانت تتمتع بحرية أكبر خارج منزلها في مجالات العمل الريفي مع زوجها أو أبيها أو أخيها، إذْ تشاركهم في أعمال الزراعة وتوفير الحطب المستخدم في المستلزمات البيتية، وغير ذلك من الأعمال، وثمَّة حالات نادرة كانت بعض النساء الريفيات يحضرن مجالس الرجال وذلك لامتلاكهن بعض سمات الرجولة كالشجاعة وسداد الرأي( ).
الطعام والشراب
أظهر الكربلائيون اهتمامًا بتحضير الأطعمة والأشربة وتوفيرها وليس ذلك بسبب الحاجة الى الطعام اليومي فقط، بل اهتم الأهالي بالأذواق الخاصة بأنواع الطعام وتحضيره بما يتعلق بالجوانب التي يظهر فيها الطابع الكربلائي في أداء الطعام، وهذا ما عُرفت به الأطعمة الكربلائية على وجه أخص، فقد تباينت أنواع الأطعمة حسب القدرة المادية للأسر، فالأسرة الثرية كان طعامها يشتمل على اللحوم والخضراوات، مع مختلف أنواع الاشربة وأنواع الفواكه، وحرصت تلك العوائل الثرية في الحفاظ على وجاهتها من خلال تقديم أنواع الأطعمة والأشربة التي تستهلكها أو تقدمها للضيوف، أما أطعمة أغلب الشرائح الاجتماعية الأخرى، فإنها كانت تتراوح بين أنواع من الأغذية المستحضرة كالبقوليات، العدس والحمص، والدولمة وأنواع من الأطعمة الخاصة بالمطبخ الكربلائي، أما ما يتعلق بنظام الغذاء في العائلة، فكان هناك ثلاث وجبات يومية، الاولى في الصباح، ويطلق عليها اهالي كربلاء تسمية "الفطور– الريوك"، وتشتمل عموماً على الحليب ومشتقاته فضلاً عن البيض المسلوق وما شاكل ذلك، أما فطور العوائل الثرية فقد يُضاف لهُ العسل والسمن (الدهن الحر) والقيمر والكاهي، وهذا يتناسب، أما الوجبة الغذائية الثانية، فتعرف بـ"وجبة الغداء" التي تتضمن الرز بصورة عامة وأنواعاً من المرق، كالباميا والباذنجان وما شاكلها، وقد تُقدَّم أنواع اخرى من الغذاء، ومنها كبة البرغل، ولاسيما في فصل الشتاء، في حين تقتصر وجبة العشاء على بعض الأطعمة الخفيفة، ومنها الخبز والخضراوات واللحوم بالنسبة للعوائل الثرية، أما العوائل الفقيرة فأنها تقتصر في غذائها على تناول بعض الفواكه منها البطيخ والرقي( ).
ويتناول الكربلائيون في طعامهم الفواكه ما بين الوجبات الرئيسة وحسب موسمها، ولعل من أبرز تلك الفواكه التين والرمان والخوخ والعرموط والتفاح والرقي والبطيخ( ) كذلك يتناول بعضهم الحلوى بعد وجبات الطعام، ومنها البقلاوة والمحلبية وحلاوة التمر والشكرلمة والكاهي، وهذه الأنواع من الحلوى تتوفر لدى الأُسر كل حسب قدرتها المادية( )، كذلك تُستهلك الألبان سواء كانت ألبان الأبقار أم الجاموس، وتعود مصادر الألبان الى الحليب الذي يجلب من مناطق ريف كربلاء إلى أسواقها، وكان لمعمل ألبان كربلاء الذي افتتح عام 1962 دوراً كبيراً في تجهيز المدينة بالمنتوجات الغذائية، واتبع الكربلائيون أخلاقيات الشريعة الإسلامية وآدابها في كيفية تناول الأطعمة، فعند المباشرة بتناول الطعام تبدأ الاسرة بالبسملة "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويراعى في اثناء تناول الطعام الصمت وعدم الثرثرة والكلام على مائدة الطعام، وعند الانتهاء من تناول الطعام تذكر الأسرة نعمة الله تبارك وتعالى عليها فيقول أفراد العائلة "الحمد لله" .
أما أنواع الأطعمة الشعبية التي يتم تحضيرها في الأسواق فكان باعتها يعتمدون عليها وسيلة للعيش، ولذلك نلاحظ ظهور أشخاص عُرفوا بأعداد أنماط معينة من الطعام، فهناك باعة الكباب، ويعرف لدى أهالي كربلاء بتسمية "الكبابـﭽـي"، فضلا عن بيع (الباﭽة) والخبز والقيمر والحلويات والطرشي والحمص المطبوخ، أما في مجال المشروبات فقد اعتنى أهالي كربلاء بالماء بوصفه أصل الحياة وعامل استمرارها، ولذلك حرصوا حرصًا كبيرًا على تنقيته وتبريده في فصل الصيف، فضلا عن الأشربة الأخرى التي كانت رائجة في المجتمع آنذاك، عصير الفواكه المستخلص من نومي البصرة وتمر الهند والزبيب وكانت هذه الأشربة تستهلك من قبل أفراد العائلة، فضلا عن كونها وسيلة ذات وجهة اجتماعية، اذ كانت العائلة تقدم لضيوفها أنواع العصائر( ).
المعتقدات الشعبية
لكل مجتمع من المجتمعات البشرية خرافاته ( ) وأساطيره ( ) الصادرة عن تصور شعبي هدفه البحث عن الشعور بالأمان والاطمئنان، ومن تلك المعتقدات ما يراهُ الناس في كربلاء في نظام الأشهر والأيام، فعلى سبيل المثال لا الحصر يعقد الكربلائي العزم على السفر بعد إثبات نيته بتنفيذ السفر يوم الاثنين والخميس دون غيره من الأيام لأنها أيام تجلب السعادة، وكان أهالي كربلاء يعتقدون بعدم جواز قص أظافرهم في يومي الأحد والأربعاء( )، كذلك يعتقدون إذا أصيب شخص بمرض يقال أنه اصابته عين او "فزة"، فيؤخذ الى امرأة كبيرة بالسن تقوم برمي مقدار من الماء وسكين حاد في مكان الحادث أو تقوم بتذويب رصاص في وعاء على رأس المريض ثم يبخرونه بالحرمل( ).
كما أنهم يعتقدون أنَّ كنس ساحة الدار في وقت الغروب يجلب التشاؤم وحلول الفقر في هذا البيت( )، وقد لا يستحمون في ايام الأحد والثلاثاء والأربعاء( ) في حين يحرص الكربلائيون على إيقاد الشموع في النهر عصر يوم الجمعة حيث تُلقى في نهر الحسينية النذور لصاحب الزمان الأمام المنتظر طلباً لقضاء الحوائج( ).
وفي مجال المعتقدات الشعبية المتصلة بالمرأة فأن الكربلائيين يرون أنَّ المرأة بعد ولادتها مولوداً ذكراً ينبغي عليها الذهاب الى الحمام في يوم الجمعة، وذلك لاعتقادهم أن هذا اليوم مبارك( ) وفي حالة عدم انجاب المرأة جراء العقم فأنها لا تيأس، إذ تبدأ بالبحث عن الطريق التي يمكن من خلالها حل مسألة الإنجاب، وذلك بالذهاب عادة الى المراقد أو تقصد الملالي من خلال الرقية التي تعرف في كربلاء بـ"التعاويذ" بهدف الإنجاب، وعندما لا تجدي تلك الوسائل نفعاً تلجأ المرأة الى غسل ملابس الوليد حديثاً الذي لم يكمل الأربعين يومًا من عمره، وكذلك تلجأ المرأة الى غسل رأس المرأة حديثة الولادة أملاً في الانجاب( )، وفي حال أنّ المولود لم يكتب له الحياة عندها تنذر المرأة التي لا يعيش لها مولود أن تلبس حجلاً حديدياً حيث تقوم بقطع من كل جسر مسماراً حتى يكون مجموعها سبعة مسامير وتعطيها للصائغ فيذوبها ويعمل منها (فردة حجل) حديدي تلبسه في رجلها ( ).
وإذا تعسَّرت امرأة في ولادتها لثلاثة أيام أو أكثر، فلا بُدَّ من أخذ خاتم من شخص معروف بعمل الأدعية والتعاويذ ويشد بساق المرأة اليمنى عند ذلك تلد المرأة، أما إذا أُصيب شخص بنزيف دموي يؤتى بخاتم عقيق يماني خاص أو تجلب قطعة عقيق وزنها ربع كيلو ويشد بالفخذ الأيسر حتى يقطع الدم( )، كذلك تعتقد المرأة الكربلائية عندما ينام طفلها ويقوم يطقطق أسنانه (يگرط) تهرع إليه وتخاطبه (تأكل لحم لو فحم؟) فيحسُّ على صوتها وآثار النعاس تدب في عينيه، فإن أجابها (آكل لحم) فأنها تضربه بالصندل ضربه خفيفة على فمه اعتقاداً منها أنه سيرى مكروهاً، وإذا أجابها (آكل فحم) فهو في استقرار ولا يُخشى عليه ( ).
كذلك تنوعت مضامين الحكايات الكربلائية أساسها الوصف وهدفها الوعظ، ولعل نشاط الفكر الاسطوري ينبع من كونه احد مجالات التسلية الاجتماعية التي تثير الذهن وتنمي الخيال وتعطي التجارب ولكنها تشتمل على اهداف تربوية واجتماعية، ولهذا السبب جاءت بصيغة حكايات مستوحاة من الربط بين الظلمة والجان ومنها حكاية بعنوان "شاه بريون"( ) تدور احداث هذه الحكاية عن طلب المراد من الله تعالى، ويبدو ان هذه اسطورة فحواها صوم نصف نهار في اخر اربعاء من شهر رجب يطلق على ذلك اليوم لدى الكثير من النساء الكربلائيات "شاة بريون"، حيث ان النساء يصومن من صباح ذلك اليوم حتى قبيل اذان الظهر، حيث يفطرن على مأكل المائدة الخاصة التي تشمل على ابريق ماء وياس وشموع وحلاوة والحناء والخضروات ومواد أخرى كالفواكه والمأكولات موضوعة على المائدة تسمى بأسماء الذين يطلب لهم المراد، وإذا تحقق الطلب فأنهن في السنة المقبلة سوف يجلبن الشموع وينصبن المائدة وتدعو صاحبة المائدة مجموعة من النساء والبنات ذلك الحي لطلب المراد( ).
وللكربلائيين اعتقادات فيما يتعلق بالطيور، إذْ كانوا يتطيرون من مشاهدة الغراب الأبقع كونه يمثل شؤماً أو يعقبه نذير شر بوفاة أحد أفراد الأسرة، ولذلك كانوا يهرعون لدى سماعهم نعيق الغراب الى القول بكلمتي (سكين وملح) أو (خير.. خير..) أما إذا حط غراب على أحد المنازل فذلك يمثل البلاء والمصائب التي ستحل بأهل ذلك المنزل( )، وفي مقابل ذلك فقد كان لأهالي كربلاء تصورات عن عراك العصافير في المنزل، فهي دلالة على أمور ثلاثة أما بشرى بهطول الامطار أو قدوم مسافر أو تشاؤم لوقوع خطر محدق بالعائلة( )، وفيما يتعلق بالأطفال فإنَّ للناس في كربلاء معتقدات خاصة، ومنها إذا تأخر الطفل عن النطق بما لا يتناسب مع عمره فإنَّ الأُم تلجأ الى وضع إناء صغير في قفص البلبل، وعندما يشرب البلبل من هذا الأناء، تأخذ الأُم بقية الماء لتسقيه ابنها بهدف مساعدته على النطق والكلام.
ولا يخفى إيمان أهالي كربلاء بقدرة أولياء الله وعلماء الدين المباركين المدفونين في أضرحتهم، فيقصدون تلك الاضرحة الطاهرة للزيارة والدعاء والتقرب الى الله تعالى، وإيفاء الديون، ودفع الامراض والتوسعة في الرزق، وكانت أغلب تلك الزيارات والهبات والنذور تذهب لضريح الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس( ).
المصادر والمراجع
القران الكريم
أولا : المراجع العربية
- ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، بيروت، 1990.
- احسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، بيروت، ط1 1999.
- باسم عبد الحميد حمودي، عادات والتقاليد الحياة الشعبية في كربلاء ، دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، 1986.
- حليم بركات، المجتمع العربي المعاصر، ط5، بيروت، 1996.
- خديجة أنس الحريري، أثر التصنيع في العائلة العراقية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1982.
- زهير حطب، تطور بنى الأسرة العربية، لبنان، 1980.
- سلمان هادي آلـ طعمة، كربلاء في الذاكرة، مطبعة العاني، بغداد، 1988.
- سلمان هادي آلـ طعمة، حكايات من كربلاء، دار الجوادين، بيروت، 2006.
- شريف الجواهري، مثير الاحزان في احوال الائمة الاثني عشر، النجف، 1966.
- طالب علي الشرقي، النجف الاشرف عاداتها وتقاليدها، مطبعة الآداب، النجف الأشراف، 1977.
- عامر رشيد السامرائي، لمحة على الازياء الشعبية، د. مط، بغداد، 1970.
- عامر سليمان، الحياة الاجتماعية والخدمات في المدن العراقية، المدينة والحياة المدنية، بغداد، 1988، ج1.
- على الوردي، لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث، مطبعة الأرشاد، بغداد، 1969.
- عبد القادر عرابي، المرأة العربية بين التقليد والتجديد، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
- عبد الصاحب ناصر آلـ نصر الله، بيوتات كربلاء القديمة، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2011.
- فاضل عبد الواحد علي، عامر سليمان، عادات وتقاليد الشعوب القديمة، موصل، 1979.
- فائق مجبل الكمالي، قبسات من تراث كربلاء، مطبعة الكفيل، كربلاء، 2016.
- مكي الجميل، البداوة والبدو في البلاد العربية دراسة لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ووسائل توطينهم، بيروت، 1962.
- مكي الجميل، البدو والقبائل الرحالة في العراق، بغداد، 1956.
- محمد مهدي الموسوي، معجم القبور، مطبعة النجاح، بغداد، 1939.
- محمد حسين الكليدار، مدينة الحسين(عليه السلام) او مختصر تاريخ كربلاء، مطبعة أهل البيت(عليهم السلام)،كربلاء، 1971.
- نوري البرازي، البداوة والاستقرار في العراق، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1969.
- وليد محمود الجادر، الأزياء الشعبية في العراق، بغداد، 1979.
ثانيا:الرسائل والاطاريح
- سالم عمر، الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الحلة 1920-1932، رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 2010.
- سهير عباس كاظم عباس الزبيدي، الأحوال الاجتماعية في منطقة الفرات الأوسط من خلال كتب الرحالة الأجانب (1831-1914)، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بابل، 2012 .
- عز الدين عبد الرسول عبد الحسين، الاتجاهات الإصلاحية في النجف 1932- 1945، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2004.
- مجيد جمعة محمد البياتي، الأسطورة في فلسفة افلاطون نظرة معاصرة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1988.
ثالثا: الدوريات
- التراث الشعبي، "مجلة"، أزياء العرب الشعبية، العدد 8 لسنة 1964.
- التراث الشعبي، "مجلة"، المجلد الاول، العدد 12، تموز، الموصل، 1970.
- التراث ألنجفي، "مجلة"، العدد (6)، النجف، نيسان، 2007.
- التربية، "مجلة"، عدد 57، قطر، 1983.
- الشعاع، "مجلة"، النجف الاشرف، العدد 27، السنة الأولى،20 آب 1948 .
- علوم انسانية "مجلة"، امستردام، العدد6، شباط 2004.
- المعرض الدائم في بابل / كلية الفنون الجميلة في بابل
- المعرض الدائم في واسط / جامعة واسط
- المعرض الدائم في كربلاء / البيت الثقافي في كربلاء
- المعرض الدائم في البصرة / البيت الثقافي في البصرة
- المعرض الدائم في تكريت / جامعة تكريت
- المعرض الدائم في الفلوجة / البيت الثقافي في الفلوجة
- المعرض الدار الدائم في الديوانية
- المعرض الدار الدائم في ذي قار
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()