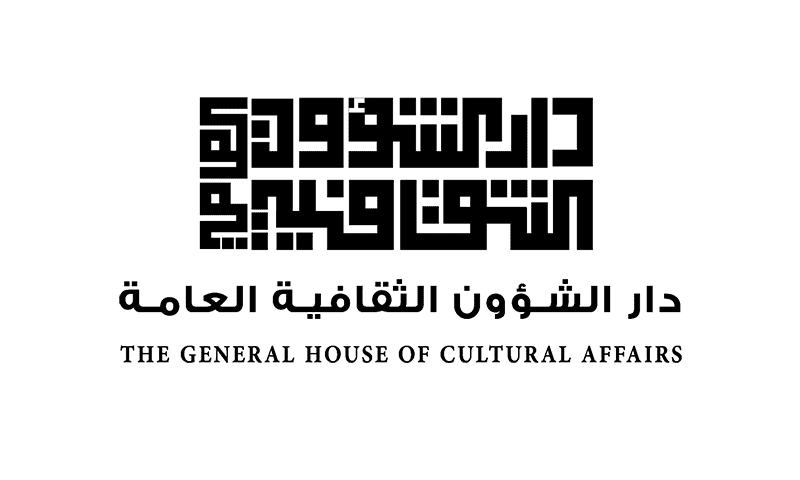دراسات وبحوث
مظاهر الرفض الجزائري للمحتل الفرنسي في ضوء خطاب المثل الشعبي
مظاهر الرفض الجزائري للمحتل الفرنسي في ضوء خطاب المثل الشعبي
د. فارس كعوان
مخبر التراث والدراسات الاثارية
جامعة سطيف2- الجزائر
مقدمة
يُعدّ المثل الشعبي جنسا أدبيا متميزا لما له من خصوصيات وقدرة على حفظ وترجمة أفكار وذهنيات أفراد المجتمع، فهو الوعاء الذي تصب فيه ثقافة المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف ومعتقدات.
وقد أهّلته هذه الخصوصيات للشيوع والتداول بين الأوساط الشعبية، مما ساعده على الانتشار، فتعدّدت وظائفه نتيجة لذلك، وانتقل دوره من التسلية والترفيه إلى التخفيف من آلام البؤساء والمسحوقين، بلغة ساخرة ومُتهكّمة من أوضاع العصر، وذلك عبر توظيف ألفاظ سهلة التداول بين مختلف شرائح المجتمع، وحمله لبعض الإيحاءات والإيماءات الرمزية.
وإن كانت الإدارة الكولونيالية في الجزائر قد كبحت جماح المجتمع، وكبّلته بمجموعة من القوانين الرّدعية التي تراقب كل حركاته وسكناته، فإن المثل الشعبي صار الملاذ الوحيد للبوح بمكبوتات المجتمع، والتعبير عن ممانعة مضمرة للسياسة الكولونيالية في مختلف مظاهرها وأبعادها.
كما حفظ هذا المثل الشعبي معالم الهوية للمجتمع الجزائري، وعبّر عن انشغالات الهامشيين والمنبوذين، وكان بمثابة منبر من لا صوت لهم من المظلومين.
حمل المثل الشعبي على عاتقه البوح في خطاب صامت عن رفضه للوجود الاستعماري منذ البداية، كما عبّر عن رفضه للتعاون مع الإدارة الكولونيالية وأعوانها، ونبذ كل مظاهر الاتصال معها، وسخر ذلك المثل من الواقع بلغة بسيطة وواضحة مما جعله متنفسا للفئات المضطهدة تلجأ إليه كآلية للتعويض عن الحرمان والقهر.
ونحن سنحاول الغوص في عمق المثل الشعبي الجزائري خلال الحقبة الكولونيالية، لاستجلاء شتى مظاهر الرفض في هذا المثل، ورصد مختلف الآليات التي وُظفت في هذا الخطاب الصامت، الذي عبّر بصمته عن قضايا المجتمع أكثر من ضوضاء الخطابات السياسية في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر.
منهج الدراسة وعيناتها:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على صور الممانعة المضمرة للمحتل الفرنسي وأعوانه من خلال خطاب المثل الشعبي، والكشف عن مدى توافق الصورة المقدمة من خلاله مع الواقع التاريخي.
وقد طبقنا منهجي الوصف وتحليل المضمون لاستقراء عدد من خطابات المثل الشعبي، بعد أن جمعنا نصوصا كثيرة من مدونات مختلفة تصب كلها في هذا المنحى «أي الممانعة».
تكوّن مجتمع الدراسة من عدد من الأمثال الشعبية لا يزال عدد منها متداولا إلى اليوم، وقد سجّلنا وجود اختلاف في الصيغ التي جاءت بها بعض الأمثال بحسب اختلاف اللهجات، لكن الملاحظ هو اتفاقها في المعنى.
وأما عينة الدراسة فقد جمعت هذه الأمثال من ثلاث مدونات رئيسة هي:
- محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب: وهو كتاب هام في هذا الباب جمع فيه صاحبه المتخصص في التراث عددا معتبرا من الأمثال الشعبية بعضها لم يُعدّ متداولا اليوم، وتكمن أهمية المدونة أن صاحبها قارنها مع مدونات أخرى، وقدم لنا ترجمة فرنسية بفحواها، كنا نرجع لها أحيانا لشرح بعض ما استعصى فهمه من كلمات عامية.
- قادة بوتارن: الأمثال والأقوال الشعبية الجزائرية: هو كتاب باللغتين الفرنسية والعربية فهو يذكر المثل بالعربية ويشرحه بالفرنسية، وهو جهد معتبر جمع فيه صاحبه عددا هاما أيضا من الأمثال الشعبية، بعضها لم يرد في مدونة ابن أبي شنب، وبعضها الآخر ورد بصيغ مختلفة مما أفادنا في معرفة مدى انتشار المثل الشعبي في بقاع وفترات مختلفة.
- عبد الحميد جعكور: حكم وأمثال شعبية جزائرية: وهو من الدراسات المعاصرة التي جُمعت من عدة مصادر، ومن أفواه عدد من كبار السن، وقد حاول صاحبه أن يبين صلة عدد من الأمثال الشعبية الجزائرية بالأمثال العربية الفصيحة، وجاء المثل الشعبي على الرغم من اختلاف اللهجات قريبا من عدد من الأمثال العربية الفصيحة، كما أورد صاحب هذه المدونة الهامة الظرفية التاريخية التي ظهرت فيها بعض الأمثال الشعبية المعاصرة .
المثل الشعبي: مقاربة في المفهوم
المثل الشعبي تسجيل لفظي في جمل قصيرة لبعض ما مرّ به الإنسان من أحداث استخلص منها مواعظ وعبر، ورغب في تصديرها للناس للانتفاع بها، وهو شكل من أشكال التعبير يعكس خلفية تاريخية، وخبرة فئة من المجتمع، من خلال مختلف الممارسات والتجارب الحياتية، وهي خبرة اكتسبها الإنسان من خلال عملية إدراكية جماعية تخرج به من إطار التجربة الذاتية إلى مجال الخبرة الجماعية التي تُعبّر عن فكر ووجدان الجماعة(1).
والمثل الشعبي جملة بلاغية موجزة منغمة في الغالب، مقفلة لغويا، مجهولة المصدر في الغالب، ذات طابع تعليمي، تصاغ في أسلوب شعبي يسمو على الكلام اليومي العادي(2).
وهو خلاصة تجارب وحصول خبرة، يحتوي على معنى يصيب التجربة والفكرة في الصميم، كما أنه يتميز بالإيجاز وجمال البلاغة(3).
أشكال خطاب الممانعة المضمرة في خطاب المثل الشعبي الجزائري:
تعدّدت أشكال خطاب الممانعة المضمرة في خطاب المثل الشعبي من الدعوة للمجابهة العسكرية مع المحتل، وحشد الناس على القتال وعدم وضع السلاح، إلى الاعتزاز بالوطن والدعوة للتمسك بالدين، وذم اليهود والنصارى، والتهكم بالمحتل وأعوانه، والحث على التكتم وعدم الإفصاح عن النوايا الحقيقية لحفظ النفس والاستعداد للمعارك المقبلة، وذم زمن المحتل وتدني المستوى المعيشي خلاله.
كل هذه الأشكال من الممانعة المضمرة غذّاها خطاب المثل الشعبي الذي يبدو للبعض صامتا غير معبر عن حقيقة الواقع، لكنه على النقيض من ذلك أخذ مكانه كشكل فعّال من أشكال مقاومة المحتل.
المثل الشعبي والدعوة للمجابهة العسكرية للمحتل:
كان الخطاب الشعبي حاضرا منذ اللحظة الأولى للمواجهة مع المحتل بشتى أبعاده ليكون إلى جانب السلاح محفزا للناس على الممانعة، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى القصيدة الشعبية التي ذاع صيتها في تلك الحقبة ومطلعها: «راني على الجزاير يا ناس حزين» للشيخ عبد القادر المازوني(4).
ولم يكن المثل الشعبي غائبا عن هذه المناسبة، فقد أدرك الرواة الشعبيون منذ البداية مدى فاعليته وسرعة انتشاره، فانطلقوا يبثّونه بين الناس لزيادة قوة الممانعة بينهم، وتحفيزهم على المجابهة العسكرية.
وظهرت مجموعة من الأمثال الشعبية التي لم يُعرف قائلوها، لكنها كانت كلها تدعو إلى المقاومة حتى الرمق الأخير منها: «الجهاد في الكفرة ولو كان بالخسارة»(5) و «العدو ما يولي صديق والنخالة ما تولي دقيق»(6) و«دافع على الروح حتى تروح»(7) و «إذا تكلم البارود الرصاص ما يعود»(8) و «إذا راح مالك روح وراه»(9) و«المومن بسلاحو»(10).
والمتمعن في هذه الأمثال الشعبية يجدها تدعو لحمل السلاح، وعدم الاستكانة أمام المحتل للدفاع عن الأرض والعرض، وذلك عبر خطاب بسيط واضح، وسريع الانتشار في الأوساط الشعبية، ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تكبح جماحه، أو تمنع انتشاره مهما حاولت.
ودعت بعض الأمثال الشعبية لعدم طاعة العدو لأن» طاعة العدو هلاك(11)» مثلما جاء في أحد الأمثال، كما أن نوايا العدو غير صافية، وهو ما جاء في مثل آخر:» ما شفت في الشتا ليل دافي ولا في العدو قلب صافي.(12) «
الاعتزاز بالوطن في خطاب المثل الشعبي:
إذا كان مفهوم الوطن ملتبسا وغير واضح في الفترة التي سبقت الاحتلال، ولم يتعد نطاق القبيلة أو المدينة في غالب الأحيان، فإن العامل السياسي ممثلا في انهيار السلطة التركية وانسحاب آخر ممثليها، وترك المجتمع الجزائري وحيدا دون قيادة لمجابهة الوافد الأوروبي الجديد، هذا العامل كان مُحفّزا على ذيوع فكرة الوطن والوطنية ومغذيا لها.
وفي هذا الإطار نجد أن خطاب المثل الشعبي قد تغنّى بحب الوطن والانتماء إليه حتى في أحلك الظروف، وفضّله على الحياة الرغيدة في بلاد أخرى، ويمكن أن نورد هذه الأمثال التي تكشف بعمق عن حب الوطن، والاعتزاز بالانتماء إليه في الحقبة الكولونيالية ومنها: «وطني وطني ولا الحرير والقطني»(13) أو «وطني وطني ولو كان رقادي في القطني»(14) وجاء بصيغة اخرى هي : «وطني وطني ولو نلبس لباس القطن».(15)
كما جاء بصيغة أخرى هي : «حريق ابداني ولا فراق اوطاني»(16) وفي المغرب الأقصى هناك مثل شبيه به هو : «الحريقة بالنار ولا الخروج من الاوطان» الذي أصبح شعارا للوطنيين يرددونه كلما داهمهم عدو في قريتهم أو مدينتهم يريد إجلاءهم عنها لاحتلالها فهم يتّخذون هذا القول مبدأهم في الصمود إلى آخر رمق(17).
كما وظّف المثل الشعبي خطابا على لسان بعض الحيوانات مثل هذا المثل القائل: «أم قرقر» وهي الضفدعة «تقول جوعي في بطني ولا نفارق وطني.»(18)
وجاء أحد الأمثال مُنبّها لأهمية رابطة حب الوطن بين الناس التي تتفوق حتى على رابطة القرابة فقال: «خُوي من الوطن خِير من خُوي من البَطن»(19) لأن المتعاونين مع العدو لا خير فيهم حتى ولو كانوا أشقاء، والشقيق الحقيقي في هذه الحالة هو الأخ في الوطن والوطنية.
ونتيجة لاضطرار عدد من الجزائريين لترك أوطانهم، والهجرة لبلاد أخرى هرباً من الوضع البائس والقوانين الرّدعية الفرنسية، وسعيا لضمان قوت عائلاتهم(20)، نبّه خطاب المثل الشعبي إلى ضرورة العودة إلى أرض الوطن «كل غريب لبلادو راجع»(21) و «اللي كبرو اولادوا يرجع لبلادو».(22)
الدعوة للتمسك بالدين زمن الاحتلال في خطاب المثل الشعبي:
إلى جانب الاختراق العسكري، عمل المحتل على اختراق المجتمع من الجانب الديني عبر تشجيع المبشرين على الاستثمار في الأرض لإيجاد فئات مدجّنة ترتد عن دينها وتلتحق بركب «الرومي» وحضارته اللاتينية.
حث خطاب المثل الشعبي على التمسك بالدين في تلك الظروف العصيبة، بوصفه صمام الأمان في المواجهة مع العدو، وعامل اللحمة بين فئات المجتمع، فقد جاء الخطاب منبّها لأفراد المجتمع بأهمية العامل الديني، إذ كانت سمة التدين من أبرز سمات الشخصية الجزائرية في تلك الحقبة، كما تدل عليها عديد الشواهد الثقافية، والصمود في وجه كل محاولات التنصير التي استهدفته طوال الفترة الكولونيالية.
يظهر التعلق الشديد بالدين في تلك الحقبة في حرص الناس على بناء المساجد والمدارس القرآنية على الرغم من حالة الشظف في العيش، والبؤس الاجتماعي الذي طبع حالة غالبية أفراد المجتمع.(23)
وظهرت مجموعة من الأمثال تحث على التمسك بالدين مهما كانت الظروف ومنها : «ابحث على دينك حتى يقولو هذا مهبول» أو « إذا اختلطت الأديان احكم دينك(24)»
ذم النصارى واليهود في خطاب المثل الشعبي:
منذ استيلاء المحتل الفرنسي على الأرض لم يتوانَ الخطاب الشعبي عن الدعوة لممانعته وذم شتى سلوكياته، والتهكم منه، ومن ذلك مثلا هذا المثل القائل: «عند النصارى التقرقيب وقلة النقيب» بمعنى أن الأوروبيين تسمع عند تناولهم الطعام كثيرا من ضوضاء الملاعق والسكاكين لكن طعامهم قليل(25).
كما جاء خطاب المثل الشعبي ليمنع الأخذ عن النصارى والاحتكاك بهم «اللي ياخذ من غير ملتو يموت بغير علتو» (26) .
وفي بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر راج هذا المثل الشعبي القائل: «وين مشاو دراهمكم يا النصارى، قالو في العناد والخسارة» وكان يعتقد آنذاك أن لا جدوى من تخصيص الفرنسيين لمبالغ طائلة لاحتلال الجزائر، لأن ذلك حسبهم ضرب من الجنون، وكان المعتقد الشعبي يروج أن البلاد الجزائرية محمية بالله وان كل معتد عليها لا محالة سيعود خائب الوفاض(27).
وإذا كان ذم «الرومي النصراني» بديهيا في خطاب المثل الشعبي بوصفه وافدا محتلا غير مرغوب فيه في بلاد إسلامية لا تزال تحن للخلافة العثمانية، فإن ذم اليهود في خطاب المثل الشعبي الجزائري، وهم ضمن التركيبة السكانية المحلية يدعو للتساؤل عن خلفياته.
يلاحظ المتأمل في هذه القضية أن خطاب المثل الشعبي في بداية الاحتلال لم يُفرق بين اليهود والنصارى « اليهود في السفود والنصارى في الصنارة»(28) وذلك بسبب الظرفية التاريخية التي جعلت يهود الجزائر ينحازون كليا لإدارة الاحتلال منذ اليوم الأول والتشفي من باقي السكان، رغم أن هؤلاء اليهود كانوا يعاملون باحترام سواء من السلطة العثمانية أو حتى من مختلف الشرائح الاجتماعية(29).
ولعل هذا الانقلاب في الأدوار الذي بينته العناصر اليهودية، واستثمارها في المناخ السياسي الجديد هو ما جعل خطاب المثل الشعبي يكون حادا معها أكثر من النصارى الأوروبيين، فقد وجدنا أن مدونة المثل الشعبي قد خصصت لليهود مساحة أكبر، ومن ذلك مثلا:
«اليهودي يهودي ولوكان على اربعين عرق(30)»، وهو مثل يصور عدم الثقة في اليهود حتى لو أسلموا، ومر على إسلامهم زمن طويل(31)
- التهكم بالمتعاونين مع المحتل في خطاب المثل الشعبي الجزائري:
وظف خطاب المثل الشعبي أسلوب التهكم من الاحتلال وبعض أعوانه كأداة بليغة لإيصال صوته، والتعبير عن ثقافة الرفض لدى شرائح عريضة من المجتمع الجزائري.
ويمكن أن نوزع هذا الخطاب الرافض على ثلاث شرائح اجتماعية تعاونت مع العدو وقدمت له كل يد العون، لتسهيل عملية الاختراق بشتى مظاهرها، حتى أن الذاكرة الشعبية لا تزال تحتفظ إلى اليوم بذكرى سيئة عن هؤلاء المتعاونين المُصنّفين في الفئات الاتية:
1 - فئة المتعاونين العسكريين:
وجاء خطاب المثل الشعبي رافضا لكل أشكال التطبيع مع المحتل، كما جاء هذا الخطاب في قالب ساخر ومتهكم بكل الأعوان الذين ارتضوا لأنفسهم الانسلاخ عن بني جلدتهم، وبهذا فقد اسهم هذا الخطاب مساهمة فعّالة في خلق جدار عازل بين هذه الفئات» المنبوذة اجتماعيا» وبين مجتمعها الأصلي، وفي هذا الإطار جاء أحد الأمثال الشعبية منبها لخطر هؤلاء المتعاونين من أبناء الوطن ضد بني جلدتهم «عدوك بين جنيبك(32)» أي أن العدو الحقيقي هو الذي يكون من أهلك وبين قومك، وذلك في إشارة إلى الحرقة التي يُحسّها الإنسان من أذى أقرب الناس إليه.
ولعل هذه الخطابات اللاذعة قد اسهمت في جعل بعض المنتمين لهذه الفئة يراجعون حساباتهم في آخر حياتهم، والعودة لمجتمعهم الأصلي، وهو ما حصل مع أحد المتعاونين المعروف بالكولونيل بن داود صاحب المثل الشهير «العربي عربي ولو كان الكولونيل بن داود».
وصاحب هذا المثل هو محمد بن داود المولود سنة 1837 ببورداش بضواحي وهران، وهو ابن السيد محمد بن داود، آغا الدواير بالغرب الجزائري، بدأ دراسته في المدرسة العربية بمدينة الجزائر، وتقلد رتبا عسكرية متدرجة منذ التحاقه سنة 1855 بالمدرسة العسكرية الفرنسية بسان سير.
خلّف الكولونيل بن داود مقولته الشهيرة :» العربي عربي ولو كان الكولونيل بن داود» التي راجت في كامل أنحاء القطر الجزائري، وحفظتها الرواية الشعبية، وقصة هذا المثل أن صاحبه أراد المشاركة في إحدى الحفلات الراقصة التي كان يقيمها الفرنسيون لكنه رغم تقلده رتبة عسكرية كبيرة لم يسمح له بحضور تلك الحفلة مما جعله يخرج غاضبا ويقول هذا المثل.
وهناك رواية شفهية أخرى مفادها أن صاحب القصة سمح له بالدخول لكن السيدة الفرنسية صاحبة الحفل رفضت مصافحته في الحفل بحجة أنه عربي متسخ Sale arabe فخرج مغاضبا من الحفل وقال تلك المقولة المشهورة التي صارت مثلا شعبيا يقال في حالة قيام شخص بتقديم خدمات للغير دون أن يلقى معاملة حسنة تليق به.
2- فئة المتعاونين الإداريين:
وجاء خطاب المثل الشعبي محتقرا لهذه الفئة، داعيا لنبذها وعزلها عن المجتمع بعبارات قوية مثل : «اقتل الخديم وخلي سيدو»(33) كما جاء بصيغة أخرى أكثر حدة في بعض الجهات «اقتل القواد وما تقتلش سيدو» و «الخديم يتبع سيدو(34)».
كما قيل مثل عن المتعاونين مع المحتل والمنخرطين في صفوفه من الذين يتمتعون ببنية قوية لكنهم وظفوها لخدمة العدو وهو: «بدن وافر وقلب كافر(35).»
وتحسّر خطاب المثل الشعبي على ذهاب الرجال الحقيقيين من رجال المقاومة ومجيء أشباه الرجال من المتعاونين في قوله» راحت رجال الهيبة وجات رجال الخيبة(36)».
وتهكّم خطاب المثل الشعبي بهذه الفئة، ورثى لحالها، ومثال ذلك المثل القائل: «بعد الشيب والكبر لبسو لو برنوس احمر(37)» والبرنوس الأحمر كان خاصا بفئة القياد التي لم يتوان عن الانضمام لها حتى الشيوخ من كبار السّن طمعا في الجاه والنفوذ(38).
وحول هؤلاء القياد جاء أحد الأمثال مُعبّرا عن تظاهرهم الكاذب بالتديّن في عبارة بليغة لا تزال تتداولها الألسن إلى اليوم هي «صلاة القياد جمعة واعياد(39)» بمعنى أن صلاة هؤلاء في المناسبات فقط، ولإظهار أنفسهم أمام الناس دون التزام حقيقي بالدين.
ومن بين الفئات التي انتقدها خطاب المثل الشعبي فئة القضاة، فقد نخر الفساد والرشوة النظام القضائي في الجزائر منذ الفترة العثمانية، حيث عبّر الرحالة الجزائري الحسين الورثلاني عن ذلك عند زيارته مدينة بسكرة في الجنوب الجزائري قائلا:» وقد سمعت أن القاضي والمفتي فيها لا يتولى إلا بإعطاء لهم، وارتشاء لديهم، وكذا في غيرها من عمالة الجزائر(40).
واستمرت صورة القاضي في الذهنية الشعبية مرادفة للمرتشي، وحارم الناس البسطاء من حقوقهم، حتى أن أحد الأمثال التي كانت متداولة في قسنطينة زمن الاحتلال جاء فيها: «دار القاضي ماهيش صحيحة(41)» بمعنى أن دار القاضي ليست متينة البناء لكسبه الحرام نظرا لتعامله بالرشوة.
وفي الموضوع نفسه جاء خطاب المثل الشعبي منبها لخراب دار القاضي الظالم: «دار الظالم خربة ولو بعد حين(42)».
ولهذا السبب شنّ خطاب المثل الشعبي نقدا لاذعا للقضاة الذين انصهروا في النظام الكولونيالي، ولم يعودوا يُمثّلون العدالة التي تطمح إليها مختلف الشرائح الاجتماعية، فجاء أحد الأمثال معبرا على الرغم من اختصاره عن انعدام العدالة «الحق غاب بعد عمر بن الخطاب»(43).
وجاء خطاب المثل الشعبي ناقدا لهؤلاء القضاة مستهترا بأحكامهم في عبارات بليغة، ومن بين الأمثال الشعبية المعبرة بخطاب مضمر عن الفساد هذا المثل القائل: «إذا عاد القاضي خصيمك غير طبق حصيرك»(44) بمعنى إذا احتكمت للقضاء فإنك لا محالة ستخسر قضيتك.
ودعا خطاب المثل الشعبي إلى الامتناع عن الشكوى للقاضي لأنه لن ينصف الناس، فجاء هذا المثل: «الشكوى لربي خير من قاضي العرب»(45) كما جاء أحد الخطابات واضحا في هذا المعنى: «الرشوة تعمي قلوب الحكام»(46).
وجمع أحد الأمثال في خطاب بليغ عددا من الفئات المتعاونة مع المحتل في مصير واحد: «القاضي والعدول والقايد والشهود في جهنم قعود»(47).
3_ فئة المرابطين وأصحاب الزوايا:
شكّلت هذه الفئة نموذجا آخر من نماذج التعاون والتطبيع مع المحتل على حساب الشرائح المسحوقة، فقد رأى منتسبوها أن من مصلحتهم الانحياز للإدارة الكولونيالية، والالتحاق بركب الأعيان، وأصحاب المصالح من بورجوازية المدن، حفاظا على مكاسبهم، ومحاولة للاقتيات من المرحلة الجديدة(48).
ونظرا لهذه الصورة السيئة التي بدا بها بعض شيوخ الزوايا، وهذا الموقف المتخاذل والمتواطئ من بعض شيوخ الزوايا، فقد جاءت بعض الأمثال الشعبية مستهجنة لسلوكيات المشايخ، وكاشفة للدور السلبي لبعض الزوايا ومشايخها في خطاب ساخر من أمثلته: «إذا كثروا أصحاب السبح ينقطع الربح»(49) بمعنى إذا كثر أصحاب الزوايا فإن الربح يقل، وهو بهذا يشير إلى ظاهرة التنافس في الحصول على المداخيل من مريدي الزوايا.
كما أن المثل الشعبي عبّر عن ثنائية الدور الذي كان يلعبه عدد من شيوخ الزوايا في الحقبة الكولونيالية بقوله: مرابط وبوليس(50) وهو مثل مختصر لكن دلالته قوية عن صلة رجال الزوايا بالشرطة الفرنسية، فالشيوخ هم مرابطون خلال النهار في زواياهم، وأصحاب تقارير تسلم للـشرطة في المساء، وهذا الوضع كان قائما خلال هذه الحقبة الحالكة إذ كانت السلطات الكولونيالية تكلف شيوخ الزوايا بكتابة تقارير دورية عن مختلف النشاطات في مجالات نفوذهم حتى تتمكن من تكوين صورة عن الواقع الأهلي بشتى تمظهراته، والتمكن من اختراقه وكبح أي شعور بالرفض.
وتهكم أحد الأمثال ببعض سلوكيات الرقص التي يقيمها مريدو بعض الطرق في صيغة التعجب: «قاع ذا الرقصة وما نيش فقير»(51) بمعنى كل هذا الرقص الذي أديته ولا أُعتبر من المريدين الصوفيين؟
كما تهكّم أحد الخطابات بقباب بعض المرابطين بعبارة حادة: «كم من قبة تزار ومولاها في النار.»(52)
وجاء أحد الأمثال منبها إلى ضرورة مهادنة فئة المرابطين والاحتراز منها نظرا لخطرها « كي المرابط بوس راسه وباعده»(53) أي كالمرابط قبّل رأسه وابتعد عنه.
الحث على التكتم وعدم الإفصاح عن النوايا الحقيقية:
في جو مشحون بالرعب والقمع زرعته السلطات الاستعمارية لوأد كل أشكال الممانعة في الجزائر، وجد خطاب المثل الشعبي ملاذه في نشر فكرة التكتم والاحتراز من العدو وأعوانه حفظا للروح والبدن، واستعدادا للمعارك المقبلة، وذاع هذا النوع من الخطاب وانتشر حتى خلال الفترة المتأخرة وهي فترة الثورة التحريرية التي كان فيها أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها.
نبّه خطاب المثل الشعبي على مخاطر كشف الأسرار أمام أي كان، والاحتراز حتى من الشجر والحجر، ودعا للتفطن وعدم الثقة بسبب زرع المحتل عيونه في كل مكان مثل:» خمّم قبل ما تتكلم» أي فكر مليا قبل الكلام حتى لا تقع في مواقف صعبة(54).
والسبب في ذلك قوانين الأنديجينا «الأهالي» التي سنّتها إدارة الاحتلال(55)، وبموجبها تم تقييد الحريات، ومراقبة كل الحركات والسكنات، حتى أن السلطات الكولونيالية سنّت في 30 يوليو 1848 قانونا يفرض على الصحافة في الجزائر تقديم الضمان الذي كانت معفاة منه من قبل، وبموجب هذا القانون فرض الصمت على من لم يستطع دفع الضمان المطلوب لإصدار أية جريدة(56) .
وجاء خطاب المثل الشعبي لحثّ الناس على كتمان أسرارهم، وعدم البوح بها حتى لأقرب المقربين، ومن هذه الأمثال: «اللي يكتم سره يبلغ مراده»(57) و «سلامة الانسان في حفظ اللسان»(58) و«اللسان يهلك الإنسان(59)» و «صدرك أوسع لسرك»(60) و «صدور الأحرار قبور الأسرار»(61) «واحفظ الميم تحفظك» أي اتبع أسلوب النفي حتى تنجو بنفسك.
وشبّهت أحدى خطابات المثل الشعبي الشخص الذي يكون مستودعا للأسرار ولا يبوح بها بـ»صندوق بني إسرائيل»(62) وهو مثل كان يستعمل في مثل تلك الحالات، واندثر اليوم.
كما نبّه هذا الخطاب إلى أن «طول اللسان هلاك الإنسان»(63) حتى أن الانسان حسب هذا الخطاب ملزم بعدم الائتمان حتى في المواضع الآمنة «في بلاد الامان لا تامن»(64) وجاء بصيغة أخرى هي : «لا تامن لا تامن ولا تستامن لا ترقد في بلاد الامان»(65).
ودعا خطاب المثل الشعبي للاحتراز من كل شيء مثل: «امش وعينك على كتفك»(66) و«الغابة بوذنيها.»(67)
وساعد هذا الخطاب على نشر فكرة الكتمان، وعدم البوح بالأفكار مما أدى في النهاية إلى رواج فكرة خاطئة للمحتل مفادها أن المجتمع الجزائري في حالة سكون، ولا يمكن له أن يثور لتفاجأ في النهاية باندلاع الثورة التحريرية في مناطق لم تكن السلطات تعيرها أدنى اهتمام، كما أن التقارير العسكرية التي كانت تتوالى على الإدارة الفرنسية كانت تؤكد على انتشار الأمن في ربوع البلاد، وهو ما شجّع على اتخاذ القرار بإعلان الثورة التحريرية عام 1954(68).
ذم زمن المحتل وتدني المستوى المعيشي خلاله في خطاب المثل الشعبي
من ضمن مجالات اشتغال خطاب المثل الشعبي العمل على ذم زمن المحتل بشتى العبارات الدالة على عدم الرضى وانتظار ساعة الفرج للثورة عليه، كما جاء خطاب المثل الشعبي متضمنا حالة البؤس التي وصل إليها المجتمع الجزائري، والتي مست مختلف الشرائح الاجتماعية.
ومن الأمثال الشعبية الذامة للمحتل وزمنه هذا المثل : «الله لا يعطي دولة للقندولة»(69) والقندولة عشبة شوكية تنبت في الجبال، وهي كناية عن تولّي أرذل الناس لمناصب إدارية في الحقبة الكولونيالية، وجاءت بعض الأمثال ليصبّ في المعنى نفسه «الوقت راه تقلب والحمار ولى على العود يجلب»(70) « ومعناه تغير الأدوار في الحقبة الكولونيالية، وتولّي السفلة مهمة الإشراف على المجتمع.
كما جاء خطاب المثل الشعبي مُعبّرا تعبيرا بليغا عن حالة البؤس الأهلي:» العام اللي نقول نشري فيه الكابوس نبيع فيه البرنوس»(71) ومعناه أن السنة التي يقول فيها الإنسان أن ظروفه ستتحسن، و يتمكن من شراء الكابوس «أي البندقية» يجدها أسوأ من سابقتها، فيضطر لبيع أثمن ما عنده وهو البرنوس الذي يرتديه، وهناك مثل آخر أكثر تعبيرا وهو» عمرك يا خماس الكرموس ما تشري برنوص»(72).
والخمّاس هو شخص مستغل بجهده لأرض شخص آخر مقابل نسبة الخُمس من المحصول عند جنيه، ونظام الخماسة نظام زراعي استغلالي كان معروفا خلال الحقبة الكولونيالية(73)، وأما الكرموس الوارد في المثل فهو التين، وجاء المثل بليغا في هذا المعنى، وذلك أن خمّاس الكرموس هو الأفقر بين الخماسين الآخرين، فخمّاس الأراضي يحصل على الأقل على منتوج زراعي من القمح والشعير يعينه على مواجهة نكبات الدهر، أما خماس الكرموس فلا يحصل إلا على هذا المحصول الذي يستهلك في فترة قصيرة ولا يمكن تخزينه.
وعلى الرغم من الظروف البائسة التي كان يعيشها غالبية أفراد المجتمع الجزائري، فقد دعا خطاب المثل الشعبي الى الاعتزاز بالنفس، وعدم الخنوع للمحتل مهما كانت المغريات، ومن ذلك مثلا: «أوقية حرمة ولا قنطار مال»(74) و «الحر حر ولو مسه الضر»(75) و «رقاد الجبانة ولا معيشة الهانة»(76) بمعنى الموت أفضل من حياة الهوان، وجاء بصيغة بليغة جدا هي» الحرية مع القلة خير من الكثرة مع الذلة.(77) كما جاء يدعو للحفاظ على النفس أبية «نفس فايشة خير من كرش عايشة»(78) ومعناه روح أبية خير من بطن ممتلئ وصاحبه مذلول في كنف الاحتلال.
الإدارة الكولونيالية ومحاولة توظيف خطاب التطبيع في المثل الشعبي الجزائري:
لم تكن الإدارة الكولونيالية في الجزائر تجهل الأثر الذي تتركه أشكال التعبير الشعبي في تغذية الشعور بالذات ونبذ المحتل، والنأي عن أي شكل من أشكال التطبيع معه، حتى أن الخطاب الشعبي دأب على وسم المحتل بالنجس الذي نهى الشرع عن التعامل معه.
ولم تجد تلك الإدارة من بد لمد جسور التواصل مع المجتمع الأهلي سوى تشجيع بعض أعوانها على نشر بعض الأمثال المحفزة على التطبيع معها، لإزالة الجدار العازل، وإذابة الجليد الذي ميّز طابع علاقة المحتل بالمجتمع الجزائري.
وقد انتشرت بعض الأمثال التي تدخل في هذا الباب منها: « الخدمة مع النصارى ولا القعاد خسارة»(79) بمعنى أن العمل في خدمة الفرنسيين أفضل من البطالة ، وهو ما يخدم توجهات الإدارة الكولونيالية.
كما أن هذا الخطاب المضاد للممانعة حاول أن ينتشر تدريجيا مستثمرا فرصة احتكاك الجزائريين بالفرنسيين عقب هجرتهم للعمل في المصانع والمزارع الأوروبية، مما جعل الحواجز النفسية بين الفريقين تتقلص، وبدأ عدد من الجزائريين يظهرون نوعا من الليونة في التعامل مع المحتل، كما حاول خطاب المثل الشعبي الداعي للتطبيع تلميع صورة المحتل وأعوانه.
وجاء خطاب هذا المثل متهكما بالعرب وأسلوب حياتهم الوضيع ونسوق هنا عينة منه جاءت في صيغة ذم للعرب وسلوكياتهم:» العرب جرب ما يتقرب»(80) مثلا وهو يقال للتحقير من رأي العرب ومغبة مخالطتهم.
كما حاولت بعض الأمثال تقديم صورة بيضاء عن اليهود بمدحهم واظهار بعض الصفات الجيدة فيهم ومنها: « اليهود هنود»(81) وهو يدل على انتشار المعارف العلمية ودقة الصنعة لدى طائفة اليهود مثلهم مثل الهنود، كما جاء الخطاب مادحا لليهود المتمسكين بدينهم» يهودي خالص خير من لعاب الاديان»(82) أو «يهودي سرسو ولا لعاب الاديان(83)» وسرسو اسم لمنطقة في الغرب الجزائري.
كما جاءت بعض الأمثال متهكمة من سلوكيات العربي وداعية لاستئصاله:» العربي اقتله قبل ما يتكلم» وذلك أن كلامه بليغ، ولو أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء الفرنسي لتمكن دون محام من إثبات حقه(84).
وجاءت بعض أمثال التطبيع لتنشر فكرة الخوف وعدم مجابهة العدو ومن أمثلة ذلك:» «اللي خاف نجا» و» اللي خاف سلم واللي سلم سلمت أيامه»(85) و «اللي ما يخافشي من الله خاف منو.»(86)
وصيغت بعض الأمثال الشعبية بصيغة تعكس معناها كما جاء في أصل المثل ، فقد وجدنا أن المثل القائل: « رقاد الجبانة ولا معيشة الهانة» الذي سبق أن ذكرناه قد جاء هذه المرة في خطاب التطبيع معكوسا ويحمل معنى مناقضا تماما، فجاء بالصيغة الاتية:» معيشة الهانة ولا رقاد الجبانة»(87) بمعنى أن حياة البؤس أفضل من الموت.
ومما يلاحظ عن هذا الخطاب أنه لم يلق الرواج الذي توقعته الإدارة الكولونيالية وأعوانها، لأنه كان خطابا لم يثبت فاعليته على الأرض ، وكان آنيا ومصلحيا، لم تكن له مصداقية في ظل أسلوب التعسف الذي تعاملت به السلطات الكولونيالية مع المجتمع، وزاد من نفور هذا الأخير من كل أشكال التطبيع، واحتضان خطابات الممانعة التي تبنّتها مختلف الشرائح الاجتماعية حتى قيام الثورة التحريرية وطرد المحتل نهائيا من الأرض.
خاتمة:
من خلال دراستنا التي حاولنا فيها تسليط الضوء على خطاب الممانعة في المثل الشعبي الجزائري خلال الحقبة الكولونيالية توصلنا إلى النتائج الاتية :
_ شكّل خطاب المثل الشعبي الجزائري أحد الخطابات الصامتة التي تميزت ببلاغتها ودقة تعبيرها رغم إيجازها وبساطتها، وقدمت الأمثال الشعبية الجزائرية صورة أخرى من صور الممانعة لدى المجتمع الجزائري للسياسة الكولونيالية في شتى مظاهرها.
_ كان خطاب المثل الشعبي رغم صمته خطابا ناقدا لأوضاع الفترة، ونجح في اختراق كل الحواجز التي وضعها المحتل بصفته خطابا شعبيا لا يمكن التحكم فيه.
_ اعتُبر هذا الخطاب ملاذا للفئات المنبوذة والمسحوقة في المجتمع الجزائري تُعبّر من خلاله عن آلامها وأحلامها دون قيود.
_ أدركت سلطات الاحتلال أهمية خطاب المثل الشعبي كشكل من أشكال الممانعة فحاولت أن تكبح جماحه، ولما عجزت حاولت من خلال بعض أعوانها تكوين خطاب ممانع يدعو للتطبيع مع المحتل، وتبييض صورته.
_ رغم أهمية خطاب الممانعة في الأمثال الشعبية الجزائرية إلا أنه لم ينل حقه في حقل الدراسات الأكاديمية التاريخية والأنثروبولوجية، حاله في ذلك حال حقول الممانعة الأخرى ممثلة في الشعر الشعبي والقصة الشعبية والألغاز الشعبية، هذه الحقول التي لو تم استثمارها جيدا في الدراسات الأكاديمية لحصلنا على نتائج هامة في موضوع الممانعة المضمرة للإدارة الكولونيالية، ولغطت لنا النقص الملاحظ في الببليوغرافيا المحلية المعاصرة.
الهوامش
(1) حسين رشوان: الفولكلور والفنون الشعبية من منظور علم الاجتماع، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 1993، ص 41.
(2) علي أحمد محمد العبيدي: من مستويات الدلالة اللغوية في المثل الشعبي الموصلي، مجلة دراسات موصلية، ع 14، نوفمبر 2006، ص 40.
(3) نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، بلا تاريخ، ص 139.
(4)Desparmet, Joseph: L›entré des français par cheikh Abdelkader,in Revue africaine, n° 1930, pp 229_236 .
(5) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، دار فليتس، المدية، الجزائر، 2013، ص 200.
(6) المرجع نفسه، ص 394.
(7) مسعود جعكور: حكم وأمثال شعبية جزائرية، دار الهدى،عين مليلة، الجزائر، 2012، ص 141.
(8) المرجع نفسه، ص 16.
(9) المرجع نفسه، ص 19.
(10) المرجع نفسه، ص 331.
(11) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 371.
(12) المرجع نفسه ، ص 554.
(13) المرجع نفسه ، ص 350.
(14)( Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens, office des publications universitaire, Alger, sd, p. 228
(15) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 644.
(16) Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires , p65
(17) عبد الهادي التازي : الأمثال من خلال التعامل السياسي، ضمن كتاب الأمثال العامية في المغرب تدوينها وتوظيفها العلمي والبيداغوجي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، سلسلة الندوات الرباط، دجنبر 2001، ص 393.
(18) Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires , p65.
(19) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 248.
(20) عمار بوحوش: العمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليلية،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط2، 1979، ص 51.
(21) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 490.
(22)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires , p64
(23) لخضر حليتيم: الأمثال الشعبية الجزائرية بين التأثر والتأثير دراسة تناصية دلالية، دار كردادة للنشر والتوزيع، بوسعادة، الجزائر، ط1:، 2017، ص 267 – 268.
(24) مسعود جعكور: حكم وأمثال شعبية جزائرية، مرجع سبق ذكره، ص 9.
(25) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، مرجع سبق ذكره، ص 406.
(26) المرجع نفسه، ص 115.
(27) المرجع نفسه، ص 639.
(28) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 671.
(29) حمدان خوجة: المرآة لمحة تاريخية وإحصائية على إيالة الجزائر، تعريب وتقديم محمد بن عبد الكريم، دار الوعي، الجزائر، ط1، 2017 ، ص 142.
(30) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 672.
(31) مسعود جعكور: حكم وأمثال جزائرية، ص 34.
(32) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 237.
(33) المرجع نفسه، ص 151.
(34) المرجع نفسه، ص 279.
(35) المرجع نفسه، ص 156.
(36) أحمد سيساوي: البعد البايلكي في المشاريع السياسية الفرنسية من فالي الى نابليون الثالث 1838_ 1871، أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ المعاصر، جامعة قسنطينة، 2013/2014، ص 108.
(37) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 357.
(38) الحسين الورثلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، تحقيق محمد بن شنب، مطبعة فونتانا، الجزائر 1908، ص 111 .
(39) A. Cherbonneau:Eléments de phraseologie française avec la traduction en arabe vulgaire,Constantine, imp Guende 1851, p 26 .
(40) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 257.
(41) المرجع نفسه، ص 225.
(42) _ Beudant: Essai de traduction de morceaux choisis à l›usage des arabisants, Alger, .
- typographie et lithographie A Jordan , 1900 p
(43) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 43.
(44) محمد بن أبي شنب ، ص 341.
(45) المرجع نفسه ، ص 290.
(46) المرجع نفسه ، ص 445.
(47) ينظر في هذا الشأن تراجم بعض شيوخ الزوايا في كتاب أعيان المغاربة وهو باللغة الفرنسية:
_Gouvion, M et E : Kitab Aâyane el Marhariba , Alger, Fontana 1920.
(48) مسعود جعكور: حكم وأمثال جزائرية، ص 23.
(49) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب ، ص 364.
)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens,P266. 550)
(51) bid, p139.
(52) جوزيف ديسبارمي: كتاب الطريق المستقيمة لتعليم لغة العامة، مطبعة السيد جوردان، الجزائر، 1907، ص 155.
(53) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 246.
(54) قوانين الانديجينا او كما تسميها المصادر الفرنسية القوانين التأديبية هي مجموعة من القوانين العنصرية الفرنسية التي فرضت على الأهالي الجزائريين ، انظر حولها:
(55)Julien de Lassale : Etude sur le régime disciplinaire en Algérie, Paris, F. Pichon, 1889 .
(56) الزبير سيف الإسلام: تاريخ الصحافة في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982، ص 29.
(57) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 129.
(58) المرجع نفسه ، ص 319.
(59) المرجع نفسه ، ص 535.
(60) المرجع نفسه ، ص 354.
(61) Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens, p206
(62) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 359.
(63) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 378.
(64) المرجع نفسه، ص 440.
(65)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens, p89.
(66) مسعود جعكور: حكم وأمثال جزائرية، ص 72.
(67) المرجع نفسه، ص 227.
(68) العربي دحو: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الاوراس، ج1، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1989، ص 78.
(69) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 440.
(70)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens, p21.
(71)Ibid, p14.
72)Ibid, p 49..)
(73)Georges Rectenwald : Le contrat de Khammessat dans l›Afrique du Nord, Paris, E Pedone editeur, 1912, p26.
(74) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 142.
(75) المرجع نفسه، ص 217.
(76) المرجع نفسه ، ص 292.
(77) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 220.
(78)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens, p121.
(79) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 345 .
(80) المرجع نفسه، ص 395.
(81) المرجع نفسه، ص 672.
(82) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب ، ص 672.
(83)Kada Boutarene: Proverbes et dictons populaires algériens,P129.
(84) محمد بن أبي شنب: أمثال الجزائر والمغرب، ص 395.
(85) المرجع نفسه، ص 86.
(86) المرجع نفسه ، ص 108.
(87) المرجع نفسه، ص586.
- المعرض الدائم في بابل / كلية الفنون الجميلة في بابل
- المعرض الدائم في واسط / جامعة واسط
- المعرض الدائم في كربلاء / البيت الثقافي في كربلاء
- المعرض الدائم في البصرة / البيت الثقافي في البصرة
- المعرض الدائم في تكريت / جامعة تكريت
- المعرض الدائم في الفلوجة / البيت الثقافي في الفلوجة
- المعرض الدار الدائم في الديوانية
- المعرض الدار الدائم في ذي قار
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()