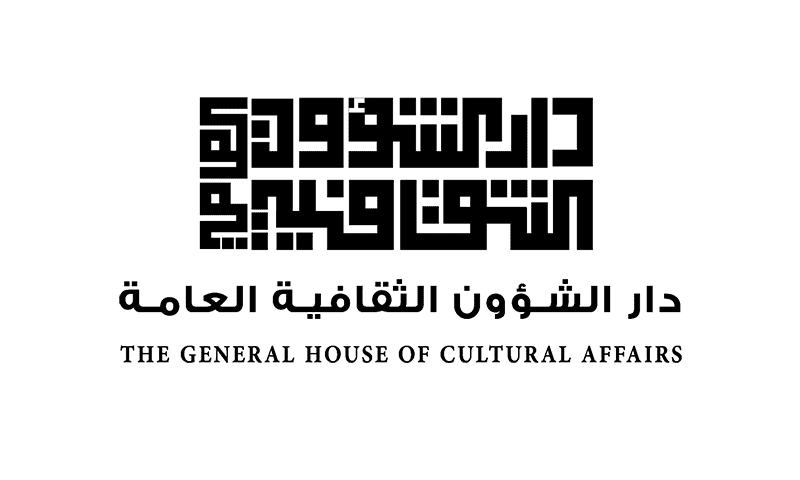دراسات وبحوث
محددات التمثل المستعادة في (رسالة الغفران) للمعري
د. علي حداد
- في البدء:
يجمع الدارسون ـ قداماهم ومحدثوهم ـ على تميّز أدب (أبي العلاء المعري) الشعري والنثري ، حتى لا يكاد يجاريه أو يقرب من فضاء ما أنجزه فيهما أي من الأدباء اللاحقين. بل لقد أضفى على منجزه امتيازات ـ في المسمى والتشكل الموضوعي ما لا يشار به لسواه، فما أن يذكر مصطلح (اللزوميات) ـ مثلاً ـ حتى يذهب الذهن المتيقن إلى أن الحديث متعلق بالمعري وحده . ومثل ذلك يقال عن كثير من كتبه الأخرى ، ومنها (رسالة الغفران) التي ستقف هذه القراءة عندها ، متأملة لها من خلال (التعليق) الذي انتدبناه مجساً لقراءتنا ، ملاحقين كشوفاته وما تبثه لنا مضامين الرسالة من تأكيدات تمثل تستجيب لمقاصد قراءتنا ومسعاها.
- المعري... الشخصية والمنجز:
لن يكون الخوض في تفصيلات سيرة (أبي العلاء المعري)(1)إلا حديثاً معاداً مكروراً، فقد تداولتها كتب كثيرة منذ زمان المعري وحتى وقتنا الراهن، وبما يغنينا عن استعادتها. وعلى هذا فما نريد تأشيره منها هنا بعض تلك العلامات والمواقف التي أرست تمايز شخصيته ودأبها (لتعليق) عاهة (فقدان البصر) التي ابتلي بها منذ سني عمره الأولى ، ساعياً من خلال ذلك أن يعيش كما الأشخاص المبصرين ، بل أن يبزهم في القدرات التي توافروا عليها(2)، معتمداً في ذلك على أحاسيسه اليقظة وذاكرته المتوقدة وخصب ما تلقاه من المعارف متنوعة المضامين ومنذ وقت مبكر من طفولته وصباه.
وكانت (الرحلة) في طلب المعرفة ونيل أسبابها ـ التي ابتدرها شاباً ـ واحدة من مواقف إصراره لتجاوز عاهته ، فقد رحل من مدينته (حلب) إلى أكثر من مدينة من مدن الشام والتقى الأدباء والعلماء وأخذ منهم ، ونال ثناءهم ، ثم قصد (بغداد) وتواصل مع أدبائها وعلمائها ، وجادل بعضهم واختلف مع بعضهم الآخر(3). وكان خلال ذلك لا ينقطع عن نظم الشعر وتأليف الرسائل وإملاء أفكاره ومعارفه وطرحه النقدي الذي حمله عديد مؤلفاته اللافتة في خصوصية ما فيها من خصب معرفي مثير.
وحين انتهى به الحال أن يعود قافلاً إلى مدينته ، معتزلاً الناس وراهناً وجوده إلى (محابسه الثلاثة)(4) التي ستأخذ من عمره خمسين سنة لاحقة فقد تهيأ له في ذلك أن يضع من المؤلفات ما أفاضت به إمكاناته المعرفية والإبداعية الفذة تلك التي كان الشعر أقلها عنده ، مقارنة بمؤلفاته النثرية في النقد وشروح الدواوين والتأملات الفكرية العميقة والرسائل ذات الاشتغالات المعرفية اللافتة(5) كان أبرزها وأكثرها شهرة واستيقافاً للتداول القرائي: (رسالة الغفران)(6) التي توجب ـ وقبل أن ندلف إلى قراءتها ـ أن نتناول أمرين ـ توقف عندهما معظم دارسي أدب المعري ـ ينضويان في التأسيس بعيد المآل لشخصيته والكيفيات التي أنجز فيها عطاءه الأدبي الخصيب، أولهما : فلسفته في الحياة والفكر والأدب ، والآخر: التكيّف اللغوي الذي تخيّره وسيلة لذلك ، ورسخ مثاله في معظم ما أنجزه شعراً ونثراً، إذ حمّل المعري شعره فلسفته ورؤاه في كل مجالات الفكر والحياة ، فجاءت قصائده ناطقة بما تيقن منه وتبناه . ولاشك في أنه لم يحد عن ذلك في مؤلفاته النثرية التي أخذت وجهة التشكل الفكري ذاتها وساوقتها مستنبتة إياها قناعات معرفية وتعبيرية قارة.
لعل أعمق ما كتب عن البعد الفكري والفلسفي عند المعري هو ما وضعه الأستاذ (عبد الله العلايلي) في كتابه المهم (المعري ذلك المجهول)(7) الذي قدم فيه مجادلة مستفيضة للبنية الفكرية التي قامت عليها شخصية المعري ، وفي جوانب تمركزها منطلقات رؤية تمثل شاملة عنده ، تداولتها كثير من الدراسات السابقة واللاحقة من دون استيقاف يفيها حقها ، ويتبنى رؤى موضوعية عنها .
يرى العلايلي أن الدارسين عرفوا المعري" شاعراً أو فيلسوفاً أو شيئاً غير واضح بينهما ، وعرّفوه للناس كذلك في شكل من هذه الأشكال. والذين زعموا فلسفته وقفوا عند حد أنه حكى أفكاراً من فلسفات شتى ، ثم جهد في أن يلائم بينها ، وقد أخفق في رأي فريق إخفاقاً عبّر عن عدم تمثيل وهضم . ووفق ـ في رأي فريق آخرـ توفيقاً معجباً "(8).
ويحاول العلايلي ـ من خلال استقراء شعر المعري ـ ولاسيما في لزومياته ـ وكذلك ما حملته مؤلفاته ـ وأبرزها رسالة الغفران ـ أن يقدم مشهداً معرفياً متكاملاً عن أفكار المعري يتجاوز تلك الرؤى المتباينة في القراءة والاستنتاج ، وذلك ما نستجليه في الآتي من قراءتنا.
يمكن ـ في البدء ـ تشخيص المكانة العليا التي يمحضها المعري للعقل ، فهو" يدعو إلى الائتمام بالعقل والاهتداء به ، وإلى أنه المخلص من الحيرة والضلال ، وهو سبيل المعرفة"(9). والمعري في ذلك يذهب ـ طبقاً لما رآه الدكتور شوقي ضيف ـ مذهب المعتزلة في تمجيدهم العقل(10).
ولا ينظر المعري إلى العقل إلا بوصفه غرساً " مزوداً بخصائص ثابتة ، أي أوليات، وهي تنمو بأشكال مختلفة من طبيعة ما يسقى الغرس به، فيجيء ضاوياً ملتوياً حيناً، وبالغاً زكياً حيناً آخر"(11) .
والعقل عنده نوعان أو مستويان : عقل فطري وآخر مكتسب، وقد انطمست معالم العقل الأول بصدأ العقل المكتسب الذي صار باعثاً لكثير من اضطراب الرؤية وضبابية التيقن في الوقائع التي تحصل من حول المرء ، فتقلق قناعاته التي لا يجاري فيها غيره ، ولا يرتضيها منه سواه ، لأن المجتهد ـ يقول المعري ـ إذا نكب (تنحى) عن التقليد " فما يظفر بغير التبليد . وإذا المعقول جعل هادياً نفع بريه صادياً . ولكن أين من يصبر على أحكام العقل ويصقل فهمه أبلغ صقل"(12) .
ومن هنا وجب السعي الحثيث إلى تخليص العقل الفطري من طفيليات العقل المكتسب وتنقيته من شوائبه وأوهامه .وذلك يتأتي ـ عنده ـ بالعزلة الحائلة بينه وبين الآخرين، "وكأن المعري يشير إلى القسرية الاجتماعية وشدة خطرها على الفكر والكائن ، ولذا هو يقودنا إلى العزلة المحصنة التي تسمح لنا بتقليب قضايا العقل على متنوع وجوهها في تمهل ، وتحليلها طويلاً في صدق"(13) .
ومن ذلك المنطلق العقلي يبدي المعري كثيراً من آرائه ، ومنها رؤيته للقدر الذي لا يعده ذا مفهوم غيبي " وإنما هي مقادير يديرها في العلو مدير ، يظفر بها من وفق، ولا يراع بالمجتهد أن يخفق" (الرسالة ،ص419) . (الرسالة، ص177).
مما يعني ـ طبقاً لرؤيته أن القدر لا يوصف بالجبر ولا بالاختيار، فهو عنده ـ بعد الاحتكام إلى التدبير الإلهي ـ " حالة عضوية تستند إلى اعتدال الأخلاط أو عدم اعتدالها، وإلى فعالية الخصائص والصفات المزود بها الأحياء"(14).
حين يترك المعري أفق الغيبيات ، ويمد باصرته نحو الحياة البشرية بتفصيلات وجودها الاجتماعي فإن آراءه تبقى متماهية مع قيم تأسيسها ولا تغادرها ، سواء أكانت تلك الآراء في السياسة التي باعد بينه وبين عوالمها ورجالاتها ، ونال من بعضهم في كتاباته وشعره، أم في الاجتماع الذي أبدى أفكاراً ومواقف جديرة بالاستقصاء ، هي رده فعله على ما كان يتناهى إليه من التكالب البشري على المطامع واستشراء الغرائز تلك التي عدّها شروراً نأى بنفسه عنها واعتزل الناس بسببها. ومن هذا المنطلق كيّف وجوده الإنساني المنفرد ، ورغب عن الزواج ، وقنع بأقل ما يكون من الطعام وأدناه(15) .
يتبدى أبو العلاء المعري مثالاً للأديب المثقف الذي اتسعت معارفه وتنوعت في مجالات اللغة وعلومها والأخبار والتاريخ والفلسفة والطبيعة وبعض خصائص النفس البشرية وما تحتكم إليه في متبنياتها القيمية ، وتأسيساً على ذلك فقد اتسعت مساحات المتاح اللغوي بين يديه حداً جعل تلميذه (التبريزي) يقول" ما اعرف أن العرب نطقت بكلمة لم يعرفها المعري"(16) .
وقد ساعده على ذلك قوة حافظته وخصب ذاكرته ، حتى روي عنه قوله : " ما سمعت شيئاً إلا وحفظته ، وما حفظت شيئاً فنسيته(17) . ومن خلال ذلك وسواه فقد توطدت له معجمية لفظية باذخة المصادر ، تجعلنا نتبنى القول أن المعري أديب " اتسع معجمه اللغوي اتساعاً واسعاً ، فتصرف بتمكن واضح وقدرة فائقة في استخدام الألفاظ "(18)، وذلك ما جعل منه " ظاهرة نادرة في تاريخ الشعر العربي"(19) .
لقد أرسى المعري وعيه اللغوي على وفق رؤية تصور فيها تراكيب اللغة كوناً غير نهائي فهي " كالأبدية السرمدية في اتساعها وامتدادها وعمقها"(20).
ومن هذا البعد الفكري عميق الغور الذي تمثله وجعله يقينه الذي لا يغادره " استحيا اللغة وتلبسها ، لا لتعبر وفق دلالاتها بل وفق دلالات نفسه ، ولا لتشير إلى ما اجتمع فيها من وحي العصور وروحها الجاثمة بل إلى ما اجتمع فيها من وحيه ولفتات روحه"(21). تلك الروح التي تضافرت مع تخيّره الذهني المجافي للمباشرة في التعبير والاسترخاء في التلقي ، متبنياً نزعة باطنية خاصة "استقل بها، واستعان ببعض مناهجها في التفكير"(22). وكأنه يسعى لمخاطبة من يمتلك وعياً نوعياً في مقدرات التلقي والفهم والإدراك يستشرف المعري وجوده ويتجه إليه في خطابه الشعري والنثري الذي أفعم عباراته بكثير من التعمية اللغوية وتقصي الدلالة الأبعد عن التداول للمفردات ، واستعادة الغريب والنادر منها ، وبما " أظهر لنا أبا العلاء واسع الاطلاع إلى حدّ لم نألفه عند سواه ، وأنه أحيا ألفاظاً كانت مواتاً ، مستوفياً قواعد اللغة والشاذ فيها ، متصرفاً بالاشتقاق والتوليد تصرف الخبير"(23)، الأمر الذي جعل بعض من قرأه من القدماء يقرّ بأن أبا العلاء " يلغز كثيراً بالأسماء المشتركة ، فيوهم أنه يريد معنى وهو يريد معنى آخر، ويصف أحد الاسمين المشتركين بصفة الآخر"(24). وهكذا أمسى صنيع المعري ـ طبقاً لرؤية أدونيس ـ " لقاء بين لفظ نملكه ومعنى نبحث عنه، لكنه بحث يؤدي دائماً إلى الحيرة والشك"(25).
وقد أدت تلك الممارسة إلى التعقيد في فهم كثير من شعره ، الذي رآه بعضهم الآخرـ مفتقداً لسمة الفصاحة ، لما قصد به من " إغماض المعنى وإخفاءه ، وجعل ذلك فناً من الفنون التي يستخرج بها أفهام الناس وتمتحن أذهانهم"(26).
ولعل الرؤية الحصيفة لهذا المآل اللغوي الذي تبناه المعري ستكاشف متبنيها بأن ذلك لم يكن عنده ممارسة مدعاة بقدر ما كان تمكناً فاض به إناؤه المعرفي الخصيب ، آزره تأمل ذهني متسع توافر عليه وهو يتطامن مع عماه ،(معلقاً) تأثير محدداته عليه، ومحيلاً إياه فاعلية منتجة من خلال اللغة التي استثمرها لتكون " عالمه الداخلي الذهني الذي يستطيع أن يجول فيه بعدما حرم رؤية العالم الخارجي"(27).
لقد روّض المعري ـ يقول طه حسين ـ قدراته المعرفية على الجهد في الإنشاء" ليسلي عن نفسه ألم الوحدة، ويهون عليها احتمال الفراغ، وليشعرها ، ويشعر الناس بأنه قد ملك اللغة وسيطر عليها، فهو قادر على أن يسخرها لما يشاء ويصرفها كما يريد، ويعبث بها إذا أراد العبث، ويجد بها إن أراد الجد"(28).
- رسالة الغفران... مصادر الرؤية والتأسيس:
(1)
تداولت مراحل الحياة الثقافية العربية ـ في عصورها كلها ـ (الرسائل) بوصفها شكلاً من أشكال الأداء الكتابي الخاص ، تمثل في أنواعها الرسمية والأخوانية ، و الرسائل العلمية الصرف ، إلى جانب تلك الرسائل ذات الصبغة الأدبية العالية التي كتبها كبار الأدباء في كل عصر، كـ (ابن المقفع) و(الجاحظ) و(التوحيدي) و(المعري) و(ابن شهيد) وسواهم من ممن أنتجوا باباً من الكتابة الأدبية يضاف إلى ما أنجز في النثر الفني العربي(29).
لقد اخذت رسائل كل منهم وجهة تأطير معرفي وجماليات أداء متميزة تؤكد شخصية كاتبها وتشير إليه وحده ، وذلك ما كان للمعري حصته الباذخة فيه ، ولاسيما في (رسالة الغفران ) التي نعاينها في هذه القراءة.
يشير الدارسون إلى أن (المعري) أملى كتابه (رسالة الغفران) في حدود سنة 424هـ بعد أن اعتزل في بيته رهيناً لمحابسه. وقد جعلها رداً على رسالة طويلة وردته من رجل أديب يدعى (أبو الحسن ، علي بن منصور الحلبي)، كان قد أبدى فيها مسائل تاريخية واعتقادية وأدبية كثيرة وجد أبو العلاء أنها جديرة بالرد والمجادلة والتصويب في كثير من مواضعها. ويبدو أن المعري لم يجعل الرد غايته حسب بل استدرج مسعاه الكتابي ليجعل من رسالته ـ بشقّيها ـ إفاضات معرفية متسعة عن القرآن الكريم وتفسيره ، والشعر وروايته ونقده ، والتاريخ والأماكن ، واللغة وكل ما يتصل بها، من دون أن يفوته الالتفات الحصيف إلى الفرق والأديان وما خفي من حياة كثير من الشخصيات(30). وذلك ما جعل من (رسالة الغفران) أن تكون
" أغنى آثار أبي العلاء تعريفاً بفلسفته ، كما نجد فيها فنية أكثر حبكة ودقة وانسجاماً ، تشهد بأنها كانت في قمة اقتعاده الفلسفي وبلوغه الأوج الفني الشامخ "(31).
ذهب الدكتور(محمد غنيمي هلال) إلى القول بأن المعري قد تنبّه إلى مصادر سبقته فاستقى منها التأسيس الأول لرسالة الغفران ، كقصة (الإسراء والمعراج) (32). مضيفاً إليها إشارته إلى مصدر آخر ذهب بالظن إليه ، فقال: " وقد يكون أبو العلاء متأثراً بمصدر فارسي في رحلته هو كتاب (أرده ويراف نامة) ، وفيه رحلة المؤبد الزرادشتي (أرده ويراف) إلى الجحيم والأعراف والجنة"(33).
ولعل كثيراً من الدارسين فاتهم أن يقفوا عند ما كان الجاحظ قد صنعه في رسالته (رسالة التربيع والتدوير)(34) التي لا يشك في أن أبا العلاء قد اطلع عليها وتأملها واستوعب مضامينها(35).
لقد تناولت كلتا الرسالتين شخصية محددة بالاسم هي عند الجاحظ (أحمد بن عبد الوهاب) وعند المعري (علي بن منصور) ، وكلتا الشخصيتين ذات وجود تاريخي متعيّن ـ وإن كان بحدود مبتسرة . وقد سعى الجاحظ ـ ومثله المعري ـ إلى تغييب ذلك الوجود ، لتحل مكانه التصورات التي ابتغاها كل منهما عن شخصيته .
وتضمنت الرسالتان كماً وافراً من المعلومات والإشارات الفكرية والتاريخية وأسماء الشخصيات ، وبما يعكس المساحة الخصيبة من ثقافة كلا الأديبين.
وكانت السخرية عندهما منطلق بيّن في وجهة التعبير وإن بدا صريحاً عند الجاحظ ومبطناً لدى المعري. وبما يضعنا على ضفة الاطمئنان حين نقول بتأثر المعري بما كان الجاحظ قد وضعه في رسالة (التربيع والتدوير) من دون أن نغفل دوافع كل منهما في إنجاز رسالته ، والوجهة الفكرية التي أسس عليها كثيراً من طروحاته فيها، وكذلك خصوصية البناء الذي أرسيت عليه كل رسالة منهن، إذ بنى الجاحظ (رسالة التربيع والتدوير) على صيغة (الحوار) من طرف واحد هو طرفه الذي استبطن فيه ما شاء له من التصورات عن بطل رسالته. في حين تحوّط المعري في (رسالة الغفران) للأمر ، فـ (علق) صنيع سلفه ، وذهب ليبتني لرسالته أكثر من صيغة بناء، لاسيما في قسمها الأول الذي صنع له متناً سردياً وافي العناصر والآليات .
(2)
بدت رسالة (ابن القارح) وكأنها مبعث الرغبة الكامنة لدى المعري في انتهاج سياق كتابي مختلف عن كتبه الأخرى ، وعما كتبه سواه. وربما استوجب ذلك الإشارة هنا إلى تلك الشخصية ورسالتها " لا لكونها السبب القريب المباشر الذي دعا أبا العلاء إلى إملاء رسالة الغفران فحسب بل لأن رسالة أبي العلاء كذلك لا يمكن أن تفهم ما لم تقرأ قبلها ومعها رسالة (ابن القارح) التي تعدّ بحق مفتاح الغفران"(36).
يجمع من أشار إلى وجود (ابن القارح) التاريخي ـ أن اسمه (علي بن منصور الحلبي) ويكنى أبا الحسن ، وأنه عاش في النصف الثاني من القرن الرابع والأول من الخامس الهجريين. وقد ورد ذكره عند (ياقوت الحموي) في كتابه (معجم الأدباء)، نقلاً عن أحدهم على النحو الآتي : " قال ابن عبد الرحيم : هو شيخ من أهل الأدب شاهدناه ببغداد راوية للأخبار وحافظاً لقطعة كبيرة من اللغة والأشعار، قئوماً بالنحو ، وكان من خدم أبي علي الفارسي في داره وهو صبي، ثم لازمه وقرأ عليه على زعمه جميع كتبه وسماعاته.
وكانت معيشته من التعليم بالشام ومصر. وكان يَحكي أنه كان مؤدباً لأبي القاسم المغربي الذي وزّر ببغداد.... وشعره يجري مجرى شعر المعلمين، قليل الحلاوة خالياً من الطلاوة. وكان آخر عهدي به بتكريت في سنة احدى وستين وأربعمائة، فإنّا كنا مقيمين بها ، واجتاز بنا ، وأقام عندنا، ثم توجه إلى الموصل، وبلغتني وفاته من بعد. وكان يذكر أن مولده بحلب سنة إحدى وخمسين وثلثمائة، ولم يتزوج ولا أعقب"(37). ويضيف أحد الباحثين المعاصرين في وصفه ـ من دون أن يذكر مصدره إليه ـ بأنه " كان طلعة ماكراً ، يتوسل بمراسلة عظيم المعرة إلى الشهرة والاستفادة. وقد شهر هذا القارحي الحلبي السندبادي بلقب (دوخلة) ، كما عرف بالمخاتلة وسوء السمعة"(38). والدوخلة :"سفيفة من خوص كالزنبيل يوضع فيها التمر والرطب"(39).
ربما استوجب حديث رسالتي (ابن القارح) و(المعري) الإشارة إلى بعض الأمور الشخصية المتعلقة بكلا الرجلين. فمن تأمل تفصيلات نشأة كل منهما وحياته يتبين لنا أن (ابن القارح) كان أكبر سناً من المعري الذي كتب الغفران وهو بعمر الحادية والستين، فيما كان (ابن القارح) بعمر الثالثة والسبعين ، ولعل ذلك ما دفع المعري أن يورد في كثير من الصفحات ذكره مقرونا بمفردة (الشيخ)، كقوله في واحدة من الصفحات الأولى للرسالة : " فقد غرس لمولاي الشيخ الجليل ـ إن شاء الله ـ بذلك الثناء شجر في الجنة لذيذ اجتناء". ( الرسالة ،ص140)
وقد جرى تبادل الرسائل بين الرجلين على المباعدة بينهما ، إذ ليس بين أيدينا ما يشير إلى التقائهما وتعارفهما عياناً ، على الرغم من أن (ابن القارح) زار مدينة حلب، من بين ما زاره من مدن الشام.
ومما يجلب الانتباه أن المعري ذكر اسم هذه الشخصية (علي بن منصور) وكنيتها (أبو الحسن) في أكثر من موضع في الرسالة(40)، ولكنه لم يذكره بلقبه (ابن القارح) على امتداد صفحاتها ، الأمر الذي يجعلنا لا نشارك (العلايلي) اعتقاده بأن هذا اللقب من صنيع المعري وابتداعه ، مؤسساً ذلك على" أن المترجمين له كانوا يقولون بعد ذكر اسمه هذا التعبير: المعروف بدوخله . فلو اشتهر بلقبه ذاك لعرفوه بها "(41).
وإذا تركنا جانباً قضية الالتباس في لقب ابن القارح فإن ما هو مؤكد أنه بعث برسالة إلى المعري ، وأن الأخير قد ردّ عليها بـ (رسالة الغفران) التي ستقف هذه القراءة عند قسمها الأول ، مجرين في البدء شيئاً من المقارنة بينها و(رسالة ابن القارح) التي وردت من دون اقترانها بعنونة كرسالة المعري(42).
وحين نتأمل الموضوعة الغالبة على كل رسالة منهما يتبدى لنا غلبة حديث الإلحاد والقائلين به عند (ابن القارح) في حين سعت رسالة المعري لـ (تعليق) ذلك، وانشغلت بحديث الغفران . وإذا كان الأول منغمساً بجدية من القول مدعاة فقد كانت رسالة الآخر على نقيضها ، وهو يحيل شخصية صاحبه بطلاً لوقائع اختطها في رسالته ، تماهى فيها الجد بالسخرية ، والثقافة الباذخة بطرافة السرد .
وأخيراً فإذا كانت رسالة (ابن القارح) هي منطلق السجال الفكري والأدبي بين الرجلين فإنها " وعلى الرغم من كل وجوه التملق لم تستطع أن تحتفظ لها بالهيمنة على نص المعري بل ما حدث خلاف ذلك تماماً إذ غدت قسماً مذاباً في نصه ، وجزءاً من كيان الغفران الكلي ... وصدقت بذلك نبوءة ابن القارح حين وصف من يتصدى لعالم المعري بأنه سيصير في النهاية منسوباً إليه ومحسوباً عليه وشرارة ناره"(43).
وربما يعن لنا أن نتساءل هنا عن دوافع أبي العلاء لكتابة (رسالة الغفران) فهل كانت منبتة إلى رغبة منه للرد على ابن القارح حسب(44) ، أم هي انتهاز لفرصة مؤاتية استثمرها في تقديم صنيع أدبي مبتكر ، يمر ـ وهو يصنع مسارات تشكله ـ على ما جاءه من ابن القارح في رسالته ، محيلاً شخصه بطلاً لسرد معرفي (يعلق) من خلاله وجوده الأرضي ليعرج به إلى العالم الآخر، فيضعه في خضم واحة من الغفران الذي ناله كثير من الشعراء ممن لا يظن أن ذلك يتأتى لهم . وكأن المعري يرد بذلك على ما استطرد به ابن القارح من حديث الزندقة في مواربة ملحاح ، لعل المعري أدرك أن فيها ما يمسه على نحو غير مباشر. فوصف رسالة (ابن القارح) بأنها " تأمر بتقبل الشرع، وتعيب من ترك أصلاً إلى فرع "(الرسالة ، ص139) .
وعبر ذلك السرد وبطله ذهب المعري بسخريته الشفيفة لا لينال من ابن القارح وحده بل من كثير من الشخصيات أمثاله ومن كثير من المواضعات القيمية والثقافية المدعاة التي يتبناها أولئك الذين أبدى المعري استغرابه وعجبه " من تمالؤ جماعة على أمر ليس بالحسن ولا الطاعة ، ولا يثبت أنه يقين ، فيشوفه الصنع أو يقين"(الرسالة ، ص395)(45) .
وبهذا الذي مرّ كله اكتملت مقاصد رسالة الغفران وبنيتها مستجيبة لتوجهات المعري الفكرية والنفسية التي لخصها الدكتور (إحسان عباس) في ثلاث قوى مجتمعة (46):
ـ القوى الفكرية وفلسفته الحائرة .
ـ قوة التخيل الطامحة إلى ما وراء هذه الأرض ، ولعل للعمى صلة قوية بها.
ـ الرغبة النفسية والجسدية التي كفت فتحولت إلى نوع من الأماني .
- رسالة الغفران ...تمثلات (التعليق) وقيمه:
كنا في أكثر من دراسة سابقة وضعنا (التعليق) في أنماط عدّة يتمثل كل منها سياقاً من التمثل المستوعب لجوانب النص الذي تتواتر تلك التعليقات فيه.
وكما غيرها من النصوص الأدبية المتميزة فقد استوعبت (رسالة الغفران) أنماطاً عديدة من (التعليق) بعضها كان خارج المتن النصي للرسالة والأخر ما تداوله متنها، وذلك ما سنقف عنده على التوالي.ٍ
(1)
نعدّ عنوان هذه الرسالة أول عتبات المواجهة خارج متنها، وهو عنوان يوحي بوجهة التركيز الدلالي التي ابتغاها المعري منها .
وكان المعري من الأدباء الذين تنبهوا لقيمة العنونة فأعطوا لها مكانة بارزة في تأطير مؤلفاتهم ، بل لعله من أوائل الشعراء الذين تخيّروا لمنجزهم الشعري عنونة منتجة لوظائف دلالية ينضوي تحتها كل ديوان منها بعد أن كان السائد أن تطلق مفردة (الديوان) على المنجز الشعري المتداول.
وفي السياق نفسه فقد تخيّر المعري لكل كتبه النثرية سياق عنونة يستوعبها ويدل عليها ، باثاً فيها جانباً من تمثلاته الفكرية والاستبطان البعيد لدلالاتها عنده.، وذلك ما اشتملت عليه عنونة (رسالة الغفران) ، حيث كانت (المغفرة) ـ التي محضها في البدء لابن القارح ، فأمست صك مروره الحر بين جانبي العالم الآخر، ثم أفاض بها على معظم ممن التقاهم في الجنة ـ مهيمنة دلالية أسس عليها المعري فكرة رسالته وحواراتها.
كانت الدكتورة (نادية العزاوي) قد توقفت عند عنوان الرسالة متسائلة لمَ لم يكن العنوان (رسالة التوبة) اعتماداً على تكرار هذه المفردة في الرسالة؟(47). وفي اعتقادنا أن المعري كان دقيقاً في اختيار مفردته، إذ أن (التوبة) سابقة (للغفران) . ولابد منها ليجىء هو لاحقاً بها . و(التوبة) قرار قيمي يلزم المرء به نفسه ، في حين يكون الغفران له من آخر، ولا تكاد المفردة تذهب بمقاصدها لغير الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده أمرها.
كنا أشرنا إلى انضواء (الغفران) في جنس أدبي هو (الرسائل الأدبية) ، غير أن اللافت فيها أن المعري (علق) معظم المواضعات التعبيرية التي تحكم هذا الجنس الأدبي، بما أربك مسعى (تجنيسها) لدى كثير من دارسيها . فـ (رسالة الغفران) ومنذ تكيّفها في قسمين ـ أحدهما سردي ، والآخر رد على رسالة (ابن القارح) ـ تكون قد (علقت) التموضع الأجناسي لها ، وذاك ما حدا بالدكتورة (نادية العزاوي) أن تطلق على الرسالة وصف (الهوية المعلقة)(48) .
وكانت الدكتورة (عائشة عبد الرحمن) قد سبقتها في عرض القسم الأول من الرسالة على المتداول من الأجناس الأدبية التي يمكن أن تكون حاضنة له: (المقامة ، الحكاية، الرسالة ، الأمالي) فلم تحسم الأمر ، حتى اطمأنت بعد سنوات من القراءة والتأمل فيها إلى القول أنها أقرب ما تكون إلى (المسرحية)(49) ، في حين خلد باحث آخر إلى القول بـ (قصصية) الرسالة لمّا وجدها تتوافر على معظم عناصر القص: الزمان والمكان والراوي ووجهات النظر والشخصيات(50)، وذهب غيره إلى أبعد من ذلك فأدخلها ـ مع بعض الاحتراز ـ إلى عالم (الرواية) (51).
ولعل خلف هذا التنادي في تحديد هوية (الغفران) بين هذا الجنس الأدبي أو ذاك طبيعة هذا النص " التي تجعله مختلفاً عن القالب أو الشكل العام الذي يميز كل جنس منها ، فهو إذ يشتمل على طوابع معينة تؤهله الانتماء إلى بعضها فإنه يمتلك أيضاً جوانب أخرى مختلفة عن بعضها ، مما يجعله في النهاية أقرب إلى حالة التداخل منه إلى نقاء الهوية الموحدة "(52) .
(2)
جاءت (رسالة الغفران) ـ كما أوردنا سابقاً ـ في قسمين ، أو فصلين مثلما وصفها المعري نفسه بقوله عن قسمها الأول : " وقد أطلت ها الفصل" (الرسالة ، ص379). وكان حق القسم الثاني أن يكون أولاً ، ولعله كان كذلك، فيكون المعري قد أملاه ، ثم بدا له أن يصنع إلى جانب ما قدمه من ردود مباشرة على رسالة (ابن القارح) بنية حكائية يستعيد فيها ـ فضلاً عن تلك الشخصية ـ المعلومات والأفكار التي لم تستوعبها رسالته، فصيّرها في سياق سردي ، مقدماً إياها على الرسالة (الرد) التي (علقها مؤقتاً).
وفي هذا القسم ـ وعلى مستوى التشكيل ـ يتبدى لنا (المعري) منضوياً خلف (راو عليم) أدار الوقائع السردية بالنيابة عنه، ومحيلاً (ابن القارح) بطلاً سردياً يؤكد حضوره في وقائع الرسالة وحركيتها كلها ، (معلقاً) تماماً ذكر كنيته (ابن القارح) التي ظنّ الأستاذ (عبد الله العلايلي) ـ كما مر ت الإشارة ـ أنها قد تكون من صنيع المعري، في مقابل ذكر اسمه في أكثر من موضع(53).
وكان يكرر الإشارة إليه بمفردة (الشيخ) ، مجزلاً له عبارات دعاء باذخة ، استحال الإلحاف فيها وتعليقها (تعليقاً متكرراً) سخرية لافتة ، ومكيفاً وجوده في سياق السرد من خلال ضمير الغيبة (هو) الذي يواصل تداوله في القسم الثاني من الرسالة أيضاً. وكان قد ذكر رسالة (ابن القارح) بعد عدّة صفحات من التناول ، ليعلقها (تعليقاً مؤقتاً) ، ولا يعود لذكرها إلا في آخر سطر من هذا القسم ، ليدلف إلى إجابة الرسالة في القسم اللاحق.
أطال (الراوي) وصف) الجنة بأشجارها وأنهارها وأنواع طيرها وأسماكها ، وخمرتها وأباريقها التي تسقى منها (لذة للشاربين) ، مستطرداً في ذكر الآيات القرآنية والأبيات الشعرية التي تتناغم مع توصيفاته ، ليحدثنا ـ وعلى نحو مباشرـ عن (ابن القارح) وقد استوفى وجوده فيها من دون أن يخبرنا عن الكيفية التي تحقق لـه فيها نيل تلك المكانة ، فقد (علق) سياق تسلسل الأحداث في لعبة سردية أتاحت له أن يذهب بعيداً في استطرادات وصفية عن وقائع وجولات وأحاديث لغوية وشعرية أجراها بطله مع كثير من الشعراء ، سائلاً إياهم عن ما كان لهم من أمر المغفرة ودخولهم الجنة أمنين . وحين (علق) ذلك (تعليقاً مستعاداً) رجع لأمر (ابن القارح) مجرياً على لسانه ـ في صفحات عدّة ـ وقائع لا تخلو من طرافة ـ خبر نيله الغفران ودخوله الجنة ، يسيح بين أفنائها ، ويتنعم بما فيها (54) ، ويجالس من يصادفه هناك من الشعراء وعلماء اللغة ، يجري حواراته معهم، ويلقي بأسئلته عليهم. ومن خلال ذلك كله تتجلى أنماط عديدة من (التعليق) التي نسعى إلى استجلائها في هذه القراءة .
كان المعري قد ذكر (الحيات) في أول صفحات الرسالة ، ثم علّق أمرها (تعليقاً مستعاداً) حتى آخر الرسالة حيث عاد لذكرها. وبين طيات ذلك تلاعب بدلالة المفردات (فعلّق) نهائياً المعنى القريب إلى التداول وأتى بالبعيد لها ، كما في هذه الأسطر من استهلال الرسالة : " إن في مسكني حماطة ما كانت قط أفانية ولا الناكزة بها غانية ، تثمر من مودة مولاي الشيخ الجليل ـ كبت الله عدوه وأدام رواحه على الفضل وغدوه ـ ما لو حملته العالية من الشجر لدنت إلى الأرض غصونها، وأذيل من تلك الثمرة مصونها" (الرسالة ، ص 129).
وقد فسر المعري (الحماطة) بأنها ضرب من الشجر، وأنها توصف بإلف الحيات، ثم قال في موضع آخر : " فأما الحماطة المبدوء بها فهي حبّة القلب"(الرسالة، ص130).
وعلينا هنا ـ لفهم السياق ـ أن يكون المقصود بمفردة (مسكني) هو جسده ، و(أفانية) اسم لشجر الحماط الرطب، لتكون (الناكزة) واحداً من أسماء الحية، وتكون (الغانية) بمعنى المقيمة.
لقد سمى حبة قلبه (حماطة) واكتفى بالقول أنها ضرب من الشجر(معلقاً) تحديد مسماها ، إذ هي شجرة التين الجبلي(55)، وهي شجرة تأوي إليها الحياّت إذا كانت خضراء. ثم ما يلبث أن (يعلق) بعد أسطر قليلة ذكر تلك الشجرة ومقصده منها، فيسمي حبة القلب (حضباً) ، وهو نوع من الحيات أيضاً . ثم سماها بالأسود ويقصد به الذكر من الحيات . وبذلك تكون فد تواترت في النص ثلاثة أشياء : (القلب والحية والشجرة) ، لنذهب في تأويلها مع الدكتور(إحسان عباس) في كونها الرموز التي تجمع قصة الخطيئة الأولى في حياة البشر والتي بسببها خرج آدم من الجنة . وكأن المعري يمهد بهذه المرموزية الدالة كي يعيد بطله (ابن القارح) إلى الجنة التي طرد أبوه آدم منها(56).
وحين (علق) المعري مقاصده من المسميات التي مرت فإنه يستعيد ماله علاقة بها من خلال قوله: " وإن في منزلي لأسود هو أعز علي من (عنترة) على (زبيبة) ، وأكرم عندي من (السليك) عند (السلكة) ، وأحق بإيثاري من (خفاف السلمي) بخبايا (ندبة). وهو أبداً محجوب ، لا تجاب عنه الأغطية ولا تجوب"(الرسالة ، ص132) وإذا كان وصف (الأسود) مما يطلق على ذكر الحيات ، كما مرت الإشارة ، فلعل المعري قد ذهب به هنا ـ وهو يضعه في (منزله) أي جسده ليجعله في هذه المرة وصفاً للعقل الذي يعلي مكانته مع ما ينتابه من ارتياب يستحيل اغطية تحجب قناعاته وتيقنه، مغادرين بذلك ما ذهبت إليه الدكتورة (بنت الشاطئ) حين رأت أن المقصود بالأسود قلبه(57) فإذا كان في المرة الأولى قد كنى بـ (الحماطة) عن (قلبه) فإن سياق الأفكار لا يضيف جديداً حين يعود ثانية فيكرر أن في منزله ـ قلبه نفسه ـ ذلك الأسود الذي ذكره ، ثم (علق) أمره ، ليذهب بعيداً في تداعيات أخرى ترد فيها أسماء المقصود بالأسود(الأساود) من الشخصيات العربية القديمة التي " ترتبط بصلات عامة ـ هي الظواهر المموهة ـ من قبيل : سواد اللون (عنترة ، سحيم ، نصيب...) ، أو تجانس الأسماء : (الأسود بن معد يكرب ، الأسود بن يعفر، الأسود بن المنذر...) وعمّى على الرابط الخفي الذي يجمع بينها ، وهو الصراع الداخلي المستمر والمقموع في آن واحد في داخل كل شخصية منها"(57).
يذهب الدكتور(إحسان عباس) إلى تأمل ثنائية (النور) و(الظلام) في الرسالة فيرى أن المعري (علّق) النور في الجنة التي أخذ (ابن القارح) إليها ، فـ " حيثما تأملنا افتقدنا شيئاً ضرورياً في حياة الجنة ، وذلك هو النور على تنوع فيما يرمز إليه... والنور مفقود في رسالة الغفران إلا في قول أبي العلاء : (فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة ولا عليها النور الشعشعاني) . مما يشير إشارة عابرة إلى أن الجنة يغشاها النور الشعشعاني .غير أن المعري لم يقف عند هذا النور ، ولم يتأمله وهو يطوف في الجنة . وليس العمى هو الذي صرفه عن تأمل النور ، إنما النور رمز للجلاء الفكري والنفسي وافتقاده يدل على أن هذا الجلاء لم يتم "(59).
ولعلنا لا نشارك الدكتور (إحسان عباس) هذا الرأي ، إذ أن عبارة المعري التي أوردها تشير إلى النور الغامر لكل مناحي الجنة سوى تلك المدائن . وما كان لبطله أن يتحرك بتلك الحيوية والتفاعل غير المحدود مع من يلتقيهم من دون أن يكون ذلك في مساحة ضوئية غامرة. فضلاً عن أن بالإمكان عدّ المغفرة ـ التي شملت أهل الجنان ـ في أدل معانيها مساحة من إشراقات النور الرباني الذي أنعم الله عليهم به.
ولا يمكن لثنائية (الضوء ونقيضه) أن تمرّ من دون أن نقف عند ما ألحً المعري على ذكره في أول رسالته من تداعيات مفردة (الأسود) في أوصاف أشياء وأسماء أعلام وظفها بطرافة للتدليل على مودة مدعاة يحملها لـ (ابن القارح) ، انتهى بعد استطراده فيها إلى ذكر اللون النقيض (الأبيض) بدلالات ومسميات أخرى تقصّدها(60).
وإذ تواتر التوصيف بـ (الأسود) لمكنونات شعورية تخصه فقد نأى بها عما يمكن أن يوصف بـ (البياض) ، " فإنه لينفر عن الأبيضين إذا كانا في الرهج معرضين. والأبيضان اللذان ينفر منهما : سيفان ، أو سيف وسنان... فأما الأبيضان اللذان هما شحم وشباب ، فإنما تفرح بهما الرباب ، وقد يبتهج بهما
وسندلف من تلك الثنائية لنتأمل الذاكرة اللونية التي استدعاها المعري في رسالته ، تلك التي اكتفى فيها غالباً بتداول اللونين الأبيض والأسود ، و(تعليق) الإشارة إلى الألوان الأخرى . وكان ذلك منطقياً عنده ، وهو الذي فقد بصره صغيراً ، ولا يكاد يتذكر منها سوى اللون الأحمر الذي استدعاه ليشير إلى شيئين أبى على نفسه أن يقربهما: الخمر واللحم(61).
ويبدو أن تلك المحدودية اللونية قد فعلت فعلها في طبيعة الصورة البصرية التي (علّق) فيها اللون والشكل في التجسيم الصوري الذي يستوجب حضورهما . فهو ـ مثلاً ـ حين يذكر الشعراء الذين التقاهم (ابن القارح) في الجنة يكتفي بالقول أنهم عادوا شباباً منعمين ، من دون أية إشارة إلى سيمائهم الجسدية أو ملبسهم أو إلى تفصيلات المكان الذين هم فيه ، كالذي أوردته بعض الآيات القرآنية التي تصف أهل الجنة ، ومنها قوله تعالى: (أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا)(62).
لقد جاءت الفاعلية الوصفية عند المعري ذات طبيعة ذهنية في الغالب عليها، كقوله يصف قصر أحدهم بأنه " قصر من الدرّ، قد أعفي من البؤس والضر" (الرسالة ، ص201، أو قوله :" سحابة كأحسن ما تكون السحب"(الرسالة ،ص276) .
في حين استعاض عن الرؤية البصرية في حالات غيرها بمقدرات الحواس الأخرى، كحاسة (التذوق) التي وصف من خلالها القار بأنه " شجر مرّ ينبت في الرمل" (الرسالة، ص 166) ، وقوله عن سمك الجنة (ص167) بأنه "سمك حلاوة" ، من دون أن يبين لنا شكله أو حجمه. ومثلها حاسة (السمع) التي وصف بها الأواني التي يلهو بها أصحاب الجنة ، فهم : " يتصافقون بآنية تسمع لها أصوات" (الرسالة ، ص172) . وكذلك حاسة (الشم) التي وصف بها (الثرمد) ـ وهو نبات مالح ـ وقد ترامت به الحوريات " كأجمل طيب الجنة" (الرسالة ،ص373).
التقي (ابن القارح ) بكثير من الشعراء الذين حاورهم في بعض مفردات شعرهم وهو يستنشدهم إياه. وقد (علقت) الرسالة نهائياً ما كانوا عليه من كبر السن في الدنيا، لتعيدهم ـ بعد أن غفر لكل منهم ـ إلى نضارة الشباب وحيويته(63).
وحين نتأمل أولئك الشعراء سنجد أن أكثرهم من شعراء ما قبل الإسلام ، وقليل من شعراء العصر الإسلامي. أما العصران الأموي والعباسي فليس هناك سوى (الأخطل) في العصر الأول ، و(بشار بن برد) في الآخر ، وقد أسكن كلاهما في النار مع شيء من التحفظ في أمر الأخير(64).
لقد أقام (ابن القارح) ـ في واحد من المواقف (الطريفة) في الرسالة ـ مأدبة دعا إليها عدداً كبيراً من شعراء العصرين (الإسلامي وما قبله)(65)من دون أن يكون معهم أي من شعراء العصر العباسي ، بما يبدو فيه المعري وكأنه يستعيد الرؤية التي تحصر (الاحتجاج اللغوي) بشعر تلك العصور وحده، ناظرة بعين الزراية إلى التداول اللغوي لعصرها ، وهو ما توقف عنده الجاحظ بالقول: " لم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إغراب، ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب"(66). ويبدو أن المعري كان ذا ميل إلى تلك الوجهة حين يقول : " وقد سمعت من أشعار المحدثين : إليّ وعليّ ونحو ذلك ، وهو دليل على ضعف المنة وركاكة الغريزة" (الرسالة، ص456) .
وستكون المفارقة اللافتة هنا أن المعري، وحين (علق) نهائياً ذكر شعراء العصر العباسي في نعيمه أو جحيمه لم يمنعه ذلك من الاستشهاد بكثير من شعرهم في ثنايا الرسالة كأشعار بشار وأبي العتاهية وأبي نواس وأبي تمام والمتنبي وسواهم .
وإذ يلتقي (ابن القارح) بكل شاعر من شعراء العصور الأدبية الأولى، ثم (يعلق) ذكره ويغادره من دون أن تكون به حاجة للعودة إلى لقائه ثانية فإنه يستثني من ذلك (الأعشى) الذي أورد ذكره في سياقات من (التعليق المستعاد) ، حتى تجاوز ذلك العشرين مرة وفي مواضع متعددة من الرسالة(67).
ولا نكاد ندرك سرّ المسألة إلا إذا استعدنا ما ورد في المرويات القديمة عن رغبة الأعشى في الحضور بين يدي الرسول (ص) وإعلان إسلامه ومدحه في قصيدة أعدّها ، لكن قريش ثنته عن مقصده ، وشغلته بالعطايا التي (علق نهائياً) من أجلها رغبته تلك. وكأن المعري يحيل ذلك إشارة إلى قلق النفس البشرية ، وما يصيبها من (العشو) بين قناعاتها ومطامعها، وهو ما كان لابن القارح في بعض مراحل حياته، وقد أشار إلى ذلك في سياق رسالته للمعري(68).
وربما حمل الأمر شيئاً من السخرية تقصدها المعري حين جعل ذلك المتن من الوقائع بين (بصير) يصنع رؤية سردية عن (أعشى) يلتقيه (صحيح البصر). على أن المعري قد (علق) نهائياً وجود عاهتي (العمى) و(العشو) ، ومثلها (العور) حين جعل (عوران قيس) الخمسة الذين التقاهم (ابن القارح) هناك بعيون تامة العافية(69).
يورد المعري ـ في سياق استطراداته التي (علّق) فيها مسار السرد مؤقتاً ـ واقعة لغوية طريفة تبنى على بيتين لـ (النمر بن تولب) هما(70) :
ألمّ بصحبتي وهــم هجـوع خـيال طارق مـن أم حصن
لها ما تشتهي عسلاً مصفى إذا شاءت وحواري بسمن
راح ـ بعد أن أوردهما ـ يفترض (حروف روي) أخرى غير ذلك الذي جاء عليه البيتان ، فمرّ على حروف المعجم العربي بتتابع تسلسلها ، لـ (يعلق) كل منها ويأتي بلاحقه ، مستعرضاً خبرته اللغوية ، وما اكتنزنه ذاكرته من الشواهد القرآنية والشعرية عن ذلك. وقد رأى الأستاذ (عبد الله العلايلي) في هذا الاشتغال تجسيداً لنظرية المعري في (الثنائية القدرية) التي تقوم عنده على حرية الانشاء وحرية المنزلة ، فـ " حرية الاختيار للشاعر تظهر في وضع (أم حصن) أو (أم حفص) ... إلخ وجبرية المنزلة التي تفرضها القافية ظاهرة في (حواري بسمن) أو (حواري بلمص) ... إلخ "(71) .
وضع الراوي بين يدي بطله (ابن القارح) وحوله كثيراً مما يتشهاه المرء من لذائذ الأطعمة ، وفي ذلك ـ طبقاً لرأى الدكتور (إحسان عباس) ـ نوع من إشباع الرغبات التي (علقها) المعري نهائياً في حياته الدنيوية ، فراح يفيض على بطله الكثير منها ، فقد جعله " يشتهي أشياء مما مرت في الدنيا ويكثر من استدعاء اللذائذ التي كان قد حرمها على نفسه ، أو حرمتها عليه طبيعته"(72) .
ولعل للأمر وجهة تخريج أخرى لا تخص المعري بقدر تعلقه بابن القارح الذي أبدى في رسالته إشارات إلى ما بلغه من العمر ورغبته ومطامعه في لذائذ يتحسر عليها بعد أن بلغ من العمر عتياً(73) .
وسوف نذهب مع الدكتور (إحسان عباس) في موضع آخر يتعلق بالطريقة التي وثّق المعري بها وجود كثير من (الحيوانات) التي أسكنها الجنة ، فإذا كان (علق) خلقتها الحيوانية فأحال بعضها بشراً سوياً كـ (الأوز المغنيات)(74) فإنه في مواضع أخرى أتى به على مائدة (ابن القارح) أصنافاً من الأطعمة، لكنه ما يلبث أن يجمع عظامها، ويعيدها إلى الحياة تامة الخلقة ، في نوع من (التعليق المستعاد)(75)، وربما كان خلف ذلك بعض من نوازع المعري الدنيوية التي حرّم فيها على نفسه أكل لحم الحيوان .
ويرد عنده في الخمرة ومجالسها وتساقيها هناك ما (يعلق) موقفه منها في الحياة الدنيوية ، حيث كان ممتنعاً عنها في حياته ، من منطلق احجامه عما يشين العقل وينال منه أو يضعفه ، ولذلك " فليس من قبيل المصادفة أن نراه يعبر عن هذين المظهرين معاً في رسالة الغفران حين يقول : (ويذكر ـ أذكره الله الصالحات ـ ما كان يلحق أخا الندام من فتور في الجسد من المدام فيختار أن يعرض له من ذلك من غير أن ينزف له لب ) فانظر كيف جمع أبو العلاء بين نيل الخمرـ في الجنة ـ وبين المحافظة على العقل ، فأشبع بذلك أمنية من أمانيه في الحياة الدنيوية "(76) .
وفي هذا كما في قضية الطعام ـ مارة الإشارة ـ ما لا يخص المعري وحده ، فقد كان في ذلك يترسم وجود (ابن القارح) ويستنبط أفكاره مما كان عليه ، أو مما أراده له ، من هنا كانت لمحته الدالة ـ بعد استطراده في حديث خمرة الجنان ـ أن انتهى عند بيت شعر للشاعر الخمري (أبي الهندي) ، ترحّم عليه بعده ، وقال ـ مشيراً إلى (ابن القارح) في نوع من التأكيد " ولا ريب أنه يروي ديوانه". (الرسالة ، ص143).
لقد وضع المعري شخصية (ابن القارح) تحت مجهر تأملاته الجادة والساخرة معاً، وراح يبث في وجوده ـ بطلاً لسرده ـ ما يؤتيه به خياله وتصوراته عنه ، ورغبته في إضفاء مساحة من المساجلة المعرفية المثيرة المستمدة مما حكاه (ابن القارح) عن نفسه. فحين شكا (ابن القارح) إليه في رسالته كبر سنه أرجعه المعري ومن معه في الجنة شباباً. ولما أبدى سخطه على من يشرب الخمرة سقاها له في الجنة (الرسالة ، ص52). وحين تحدث عن (الغواني) اللواتي لم يعدن يأبهن له وضع بين يديه ما شاء منهن هناك (الرسالة ، ص45) ، وإذ أشار إلى ما ينتابه من النسيان(77) جعله المعري يستعيد من الشعر ما تناساه كثير من قائليه من الشعراء (الرسالة ، ص65)
(يعلق) الراوي جولة (ابن القارح) في الجنة تعليقاً مؤقتاً ـ إذ سيعود إليها لاحقاً ـ ليذهب به في ٍجولة أخرى في الجحيم ، باحثاً عمن لم يجده من الشعراء.
وكما في الجنة فإن (ابن القارح) لا يلتقي هناك إلا بشعراء من عصر ما قبل الإسلام كـ : امرىء القيس ، عنترة بن شداد، طرفة بن العبد ، أوس بن حجر ، المهلهل بن ربيعة ، المرقش ، والشنفرى(78). أما من العصور اللاحقة فلا يلتقي بسوى (الأخطل) من العصر الأموي ، ومن العباسي (بشار بن برد) الذي مرت الإشارة إلى خبره ، وما كان الراوي ليذكره لولا أنه التقى (إبليس) الذي سأله عنه، مبدياً امتنانه لبشار أنه فضله على آدم في أبياته المشهورة(79).
وستكون السخرية بينة الإدلال حين يسأل (ابن القارح) بشاراً عن بعض ما ورد في شعره ـ وهو المبتلى بأصناف العذاب ـ فينهره قائلاً : يا هذا دعني من أباطيلك فإني لمشغول عنك(80). وكان ذلك قد تكرر معه حين لقائه بالشعراء الآخرين الذين بدا (ابن القارح) إزاءهم سادراً في لامبالاته بما هم فيه من عذاب مقيم يلهيهم عن أسئلته (البطرة) في شؤون شعرهم وقضاياه المعنوية واللغوية ، حتى إذا يئس منهم ، و" رأى قلة الفوائد لديهم تركهم في الشقاء السرمد، وعمد لمحله من الجنان" (الرسالة، ص 360) ، ليكون أبونا (آدم) أول من يلاقيه في طريقه . وكان التوقع يذهب إلى أنه سيسأله عن الخلق والوجود ومغادرته الأولى للجنة ، ولكنه ينأى عن ذلك كله ، مكتفياً بسؤاله عما نسب إليه من الشعر بالعربية، وما قاله علماء اللغة من آراء فيه(81).
واللافت هنا أن المعري (علّق) الإشارة إلى أمنا (حواء) . وقد تساءلت الدكتورة (نادية العزاوي) قبلنا عن الأمر مبينة أن ذلك " بخلاف ما اعتاده في مواضع أخرى من ذكر الشخصيات المتناظرة معاً"(82). ولعل عودة تستقري الوجود الأنثوي في رسالة الغفران ستضع بين أيدينا إشارات دالة على رؤية المعري في هذا الجانب.
لقد كان الوجود الأنثوي في الرسالة محدوداً ، ومستعاد الذكر غالباً في ظل هيمنة الإشارة الذكورية ، فلم تذكر الخنساء ـ التي قبعت في طرف الجنة ـ إلا في خبر أخيها (صخر) ، والنار تضطرم في رأسه(83). وما حضرت المغنيات في مأدبة (ابن القارح) إلا لإطراب من حضرها (الرسالة ، ص372)
وقد (علق) ذكر أي من نساء الدنيا المشهورات بالمنزلة أو الجمال فيما استحضره منهن في عوالم الجنة ، وذهب إلى تخيّر المغمورات ـ ممن لم يكن لهن نصيب من المكانة أو الجمال ـ ليحيلهن (حوريات) هنّ غاية في الفتنة (الرسالة ، ص386).
وفي مواقف أخرى تماهى حضور المرأة بسواها من أناث المخلوقات ، فصار بإمكان الأفعى أن تستحيل امرأة فائقة الحسن (الرسالة، ص370) ومثلها الأوزات السابحات في أنهار الجنة اللواتي استحلن حوريات مغنيات .(الرسالة ، ص212).
ومن اللافت أن المعري سعى إلى الإجابة عن التساؤل المتواتر حول مصائر النساء في الجنة ، فجعلهن على ضربين : " ضرب خلقه الله في الجنة لم يعرف غيرها، وضرب نقله الله من الدار العاجلة لما عمل الأعمال الصالحة" (الرسالة ، ص287). وفي كلا الضربين فقد كان المعري يتبنى رؤية تضع المرأة بمساحة من الاحتياج الذكوري الذي يشبعه وجودها معه.
لا يفوت (المعري) ـ وهو على وشك إنهاء جولة (ابن القارح) في الجنة ـ أن يستعيد موضوعة الشعر والشعراء التي شغلت بها الرسالة طويلاً . ولكنه يتخيّر هنا نوعاً من الشعر بعينه ، وذاك هو (شعر الرجز) الذي يلتقي بالمشهورين من ناظميه في بيوت متطرفة ليس لها (سموق) أبيات الجنة كون أصحابها (الرجازون) لا يدانون أصحاب القريض مكانة ، فالرجز ـ طبقاً لرأي المعري ـ "من سفاسف القريض ، وأن أصحابه قصروا فقصّر بهم" (الرسالة ، ص375). ويبدو أن موقف (المعري) من شعر الرجز مساير لموقف عام يكاد يجمع عليه كثير من الشعراء القدامى والدارسين في الزراية من الرجز من كونه سهل المنال ، ويمكن أن نجده في كلام العامة غير الموصوفين بقول الشعر ، حتى لقد أطلق عليه وصف (حمار الشعر)(84).
- في الختام:
لعله من غير المتاح أن يصل التلقي إلى مقاربة أسرار (رسالة الغفران) من دون أن يتهيأ له المجال المتسع لتأمل جملة وقائع ومحددات انبنت الرسالة عليها ، تأتي في مستهلها سيرة المعري العلمية والمثاقفة اللغوية الثّرة التي تحصّل عليها ، متماهية مع مدرك يعي البنى المعرفية والذوقية التي انسجم فيها شعره ونثره ، وتلك الرمزية التي شحن بها الغالب على مناحيه في الكتابة والتأليف ، حتى ليبدو من الواجب أن نقرأ الرسالة في ضوء شعره ، إذ هما نتاج فلسفته وفكره، ووجهة التمثل اللغوي التي دأب فيها على تقصي الألفاظ النادرة والشاردة والمشتركة ، وبها كثر إلإلغاز والإيهام عنده.
ولن يكون من المستبعد تأمل ما أتاحته له مرحلة العزلة (منذ سنة 424 هـ) وابتعاده عن الناس من فرص للتأمل والمراجعة الذهنية ، والتأليف على وفق مكتنزاتها الخصيبة.
لم يكن المعري فيلسوفاً يشتغل على نظرية مجردة بل كان أديباً مفكراً أطال تأمل ما بين يديه وما حوله ، وأرسى له وعنه تصورات عقلية متسعة الأفناء ، وبأدوات عالية المثاقفة وطويلة التأمل ، استعاد فيها الوقائع الحاضرة بمكاشفة لا تماري ، ولكنها لا تبدي ما لديها بمعجمية لغوية مباشرة، فلعمق ما لديه من إمكانات المجادلة الذهنية والثراء اللغوي أقام صنيعه الأدبي المثير الذي تجلى في (رسالة الغفران) تلك التي (علق) فيها ما كان من أمر فن (الرسائل الأدبية) عند سواه من الأدباء ، ليأتي بها على نحو متفرد في بابه.
وسيكون من الوقائع الأخرى موجبة التأمل استحضار رسالة (ابن القارح) والكشف عن مضامينها التي أعاد المعري تكييفها في (رسالة الغفران) ، للوقوف على الدوافع النفسية والفكرية التي حدت به أن يضعها في قسمين : القسم الأول بمحدداته السردية، والقسم الآخر بمجادلاته التاريخية والفكرية ، ووقوفه عند ما تضمنه رسالة (ابن القارح) منها ، فكان أن أحال القسم الأول (السردي) مكاشفة ذات طابع شعوري نفسي لما كان (ابن القارح) شغل به على كبر سنه . في حين صيّر القسم الثاني رداً على الأفكار والوقائع التاريخية التي أشار إليها في رسالته.
وإذ أبانت الرسالة عن شيء من التقصي لما كان (ابن القارح) قد أثاره في رسالته من موضوعات وأفكار فإن ذلك لم يقف في وجه تخيّر المعري لوجهة من التشكل السردي الخصيب الذي جعل من (ابن القارح) مرآته يسيّره في فضاءات من الفعل والقول وإشباع النوازع ، التي كان المعري قد نأى بنفسه عنها، وقيدها بالتزامات لم يكتف منها بما تخيّره نهجاً لحياته بل ذهب بها إلى شعره ونثره ، فألزمهما بما في دواخله من إقصاء للنوازع الآنية في الفكر والتعبير والتمثل اللغوي، وكأنه بذلك التزم البعيد من التعبير مثلما التزم البعيد من السلوك.
وفي العودة لما اشتغلت عليه الرسالة من وجود بشري توزعته الجنة والجحيم سيتبدى لنا أن المعري قد أوقف ذلك على الأدباء والشعراء ، (معلقاً) في الغالب الإشارة التفصيلية إلى سواهم من الناس، حتى بدا (ابن القارح) وكأنه مبعوثه في مهمة استطلاعية عن الشعر والشعراء حسب، مهمة أرتأى لها ذلك القالب السردي الذي بثّ ـ بين طياته ـ كثيراً من طرحه النقدي واللغوي عن الشعراء والرواة وعلماء اللغة الذين وضع منجزهم بين يديه، محدداً من خلاله بعض المفاهيم والتعريفات ، ومصوباً بعضاً من الأفكار والتوجيهات التي رآها غير صحيحة .
أخيراً فقد استعاد المعري ـ من خلال (رسالة الغفران) جوانب مهمة من مسار الشعرية العربية ووثقها ، ومنحها القدرة على ابتناء فضاءات قيمية للمنتمين بصدق إليها ، أولئك الذين كان قليل من البوح الشعري كفيلاً ـ طبقاً لتصورات المعري ـ أن يدخل صاحبه الجنان الوارفة .
وإذا كانت الرسالتان بين مبصر وفاقد البصر فسيتكشّف لنا طبائع الرؤى والنزوع الكتابي الذي استبد بهما ، ودأب المعري لـ (تعليق) عاهته وتجاوزها في ترسم فعل تخييلي مثير لم يكن للآخر ما يجاريه فيه ، حتى بدت رسالة (المبصر) ذات وجهة متسائلة تبحث عن أجوبتها عند الآخر، ليكون مسار خطابها من خلال الضميرين (أنا / أنت) الذي (علقه) المعري جاعلاً إياه بين ضمير الغيبة (هو) العائد على (ابن القارح) والضميرين (أنا) و(نحن) وكليهما يلوذ بدلالته نحو المعري.
وكان التوقع يذهب إلى أن تكون جملة رسالة ابن القارح ـ اعتماداً على ماتداولته من الضمائرـ إلى حيث فعلية حاضرة ، فبادرتنا بهيمنة الفعل الماضي على جملتها، ليكون الفعل المضارع ـ الدال على زمانية ممتدة الحضور ـ من نصيب الغفران وحدها.
*
- هوامش القراءة:
(1) ينظر: مجموعة باحثين، تعريف القدماء بأبي العلاء .ص5 وما بعدها.
(2) من الطريف أن يذكر كثير ممن تناول سيرته أن كان يجيد لعب الشطرنج والنرد وسواها من ألعاب المبصرين ويتنافس معهم بها. ينظر : المصدر نفسه ، ص551 وما بعدها.
(3) ينظر: ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ،1/310 وما بعدها.
(4) يقول المعري ، اللزوميات، 1/208.
أراني في الثلاثة من سجوني فـلا تسأل عـن الخـبر النبيث
لفـقدي ناظـري ولـزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث
(5) تجاوزت مؤلفات المعري ـ على ما أحصي له ـ المائة والتسعة بين كتاب ورسالة ومطولة في الشعر والنثر، لعل أشهرها في الشعر: ديوان (سقط الزند) و(اللزوميات) ، أما في النثر فله: (رسائل أبي العلاء) ، (رسالة الغفران)، (الأيك والغصون) ، الشاحج والباغم ، وفي شروح الدواوين : شرح ديوان أبي تمام ، عبث الوليد ، معجز أحمد.
(6)عن الدراسات التي عنيت بالغفران ، ينظر: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ، جديد في
رسالة الغفران ، دار الكتاب العربي ، بيروت1972م، ص9 وما بعدها. و: نادية غازي
العزاوي ، ص83 وما بعدها.
(7) صدرت طبعته الأولى عام 1945م.
(8) المصدر نفسه ، ص25.
(9) المصدر نفسه. ومن أبيات المعري في ذلك ، لزوم ما يلزم 1/66 :
كذب الظنّ لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء
فـإذا أطعــته جلــب الرحـمــــــة عـند المسـير والإرســاء
(10) ينظر: شوقي ضيف ، عصر الدول والإمارات، ص177.
(11) العلايلي ، ص121.
(12) المعري ، رسالة الغفران ، ص464. وسنكتفي لاحقاً بالإشارة إلى صفحات الاقتباس منها
داخل المتن .
(13) العلايلي ، ص 123.
(14) المصدر نفسه.
(15) من الطريف أن (جرحي زيدان) ، تاريخ آداب اللغة العربية، 2/ 571 ، أرجع ذلك عند
المعري إلى اختلال الهضم بتوالي الصوم والاقتصار على نوع أو نوعين من الأطعمة ،
(معلقاً) بذلك دور العوامل الفكرية التي أمست تيقناً سلوكياً تبناه المعري ونهجه.
(16) تعريف القدماء بأبي العلاء، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1965م ، ص515.
(17) المصدر نفسه .
(17) زاهد ، ص29.
(19) المصدر نفسه ، ص9.
(20) العلايلي، ص33.
(21) المصدر نفسه ، ص23.
(22 ) المصدر نفسه، ص49.
(23) المعري ،رسالة الغفران ، مقدمة المحقق الدكتور علي شلق ص11.
(24) القول للبطليوسي . ينظر: زاهد ،ص31 . وينظر مصدره.
(25) أدونيس ، الشعرية العربية ،ص 68.
(26) ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص218. ومن الأمثلة التي تخيرها لتبيان ذلك قوله:
إذا صدق الجد افترى العم للفتى مكارم لا تكرى وإن كذب الخال
الذي فسره بأنه " يريد بالجد الحظ وبالعم الجماعة من الناس وبالخال المخيلة، وقد ألغز من الجد والعم والخال من النسب ، فهذا وأمثاله ليس من الفصاحة بشيء ، وإنما هو مذهب مفرد وطريقة أخرى".
(27) زاهد ، ص84.
(28) طه حسين ، مع أبي العلاء في سجنه، ص110.
(29) ينظر : شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ص7 وما بعدها.
(30) ينظر: شلق، ص12.
(31) العلايلي ، ص85.
(32) محمد غنيمي هلال ،الأدب المقارن ، ص230.
(33) المصدر نفسه.
(34) ينظر: الجاحظ، رسالة التربيع والتدوير ، ص5 وما بعدها.
(35) من اللافت أن المعري ـ وعلى كثرة من ذكرهم من أعلام الأدباء والكتاب ـ لم يرد ذكر الجاحظ عنده. وكأنه سعى لأن يبعد الأذهان عن أية مقارنة بين (رسالة التربيع والتدوير) ورسالته.
(36) بنت الشاطئ، مقدمة الطبعة الثانية ، ص11.
(37) ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، 15/83 وما بعدها).
- مصادر القراءة ومراجعها:
- القرآن الكريم.
- أدونيس، علي أحمد سعيد :
ـ الشعرية العربية، دار الآداب ، بيروت 1985م.
- بنت الشاطئ ، د.عائشة عبد الرحمن:
ـ جديد في رسالة الغفران، دار الكتاب العربي، بيروت 1972م.
- الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر:
ـ البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي،
القاهرة ،د.ت .
ـ رسالة التربيع والتدوير، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت1969م.
- حسين ، د. طه :
ـ مع أبي العلاء في سجنه، دار المعارف ، ط 16، القاهرة 2013م.
- الحموي ، ياقوت:
ـ معجم الأدباء، تحقيق د. إحسان عباس، مؤسسة الغرب الإسلامي ،
بيروت 1993م.
- زاهد ، د. زهير غازي:
ـ لغة الشعر عند المعري، دراسة لغوية فنية في سقط الزند، دارالشؤون
الثقافية العامة ، بغداد1989م.
- زيدان ، جرجي :
ـ تاريخ آداب اللغة العربية، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت 1978م.
- ضيف ، د. شوقي:
ـ عصر الدول والإمارات،دار المعارف بمصر ،القاهرة 1990م.
ـ الفن ومذاهبه في النثر العربيـ دار المعارف بمصر ،الطبعة السادسة ،
القاهرة 1971م.
- عباس ، د. إحسان:
ـ من الذي سرق النار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت 1980م.
- عبد راضي ، د. حسن :
ـ المفارقة في شعر المعري، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد2013م.
- العزاوي، د. نادية غازي:
ـ المغيب والمعلن ـ قراءات معاصرة في نصوص تراثية ، دار الشؤون
الثقافية العامة ، بغداد2002م.
- العلايلي، عبد الله :
ـ المعري ذلك المجهول ، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت 1981م.
- مجموعة مؤلفين:
ـ تعريف القدماء بأبي العلاء، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1965م.
- المعري ، أبو العلاء:
ـ رسالة الغفران ، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف بمصر،
ط5 ، القاهرة 1969م.
ـ رسالة الغفران ،حققها وقدم لها د. علي شلق ، دار القلم ، بيروت 1975م.
- مندور ، د. محمد :
ـ في الميزان الجديد ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة 1973م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم:
ـ لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت 2010م.
- هلال، د. محمد غنيمي :
ـ الأدب المقارن، ط 5 ، دار العودة ، بيروت ، د.ت.
- المعرض الدائم في بابل / كلية الفنون الجميلة في بابل
- المعرض الدائم في واسط / جامعة واسط
- المعرض الدائم في كربلاء / البيت الثقافي في كربلاء
- المعرض الدائم في البصرة / البيت الثقافي في البصرة
- المعرض الدائم في تكريت / جامعة تكريت
- المعرض الدائم في الفلوجة / البيت الثقافي في الفلوجة
- المعرض الدار الدائم في الديوانية
- المعرض الدار الدائم في ذي قار
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()