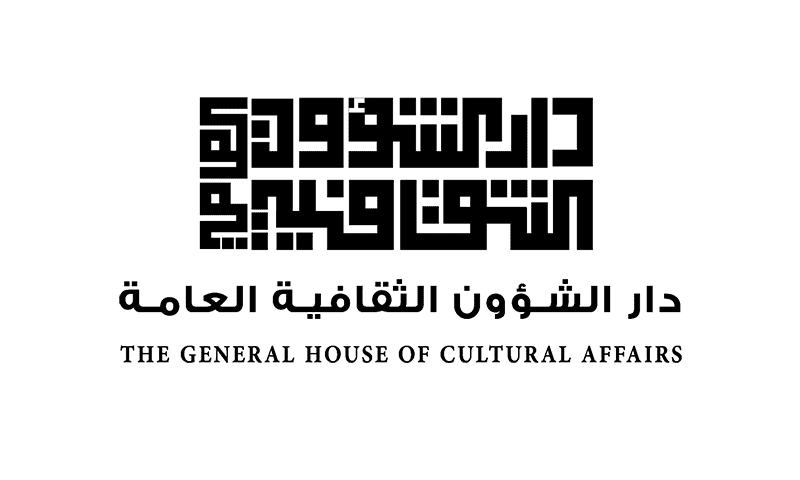دراسات وبحوث
التفكير الأجناسي في كتاب (البرهان في وجوه البيان) لابن وهب الكاتب
التفكير الأجناسي في كتاب
(البرهان في وجوه البيان)
لابن وهب الكاتب
أ.د فاضل عبود التميمي
جامعة ديالى: العراق
تقديم:
يسعى هذا (البحث) إلى الوقوف عند ظاهرة التفكير الأجناسي الذي مارسه أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب (335هـ) في كتابه (البرهان في وجوه البيان) الذي حققه د. أحمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي -رحمهما الله-، و (البحث) في هذا السعي يريد أن يدقّق في المعايير المشكّلة لطبيعة الخطاب الذي بكَّر الحديث فيه (ابن وهب) بطريقة يشمّ منها حضور الماضي ممثّلا في البحث عن هوية الأدب العربي ، وتحديد أجناسه ، فضلا عن أنواعه ، وقد اعتمد (البحث) منهجا وصفيّا حلّل المقولات ، وألزم نفسه بالرؤية المنطلقة من النص ، والمنضبطة في حدود شبكته الدلاليّة ايمانا منه بقيمة مصطلح الأجناس الناتج عن فعل اللسان ، وقد تمكّن دراسته في ذاته ولذاته ، فهو في المحصلة ضرورةٌ معياريّةٌ تلفت النظر إلى السمات الفنيّة التي تتمتع بها الأشكال الكتابيّة من خلال تأريخ الأدب ؛ ولهذا كان للمعيار ولمّا يزل أثرٌ في تحديد النوع الأدبي ، يستند إلى طبيعة اللغة ، وشكل البناء ، ووجود القصد على أنّ المعيار نفسه لم يكن اختيارا محضا تستعيره الذائقة النقديّة من دون أن تستند إلى جملة حيثيّات ، ومبادئ ، وتصوّرات عمرها مئات السنين ، لها تأثيرها الواضح في تقبل الأدب ، وتنمية أنواعه واتجاهاته.
المدخل:
كان(ابن وهب الكاتب) قد تقصّى فكرة الأجناس الأدبيّة كما نفهمها اليوم في كتابه (البرهان في وجوه البيان)( ) من فضاء الحاجة النقديّة للأدب نفسه، بعد أن قطع الأدب شوطا طويلا في التشكّل ، والتنوّع ، متوازيا وشعور النقّاد والأدباء بالحاجة الملحّة لأنْ يُنَظَّم في أشكال إبداعيّة تضمن له حدودا مرسومة ، وتقاليد كتابيّة متّفق على صفاتها ، وطبيعتها ، وهذا يعني أنّ الرغبة النقديّة بما تملك من سعة في المفاهيم ، والإجراءات كانت قد نادت بضرورة تقسيم الأدب على أجناس ، والأجناس على أنواع بوصف التقسيم سلطة نقديّة تستند إلى ما يقوله اللسان ، وتجتهد في تحليله المقولات النقديّة.
في مقدمة الكتاب أشار (ابن وهب) إلى سبب تأليفه، رابطا إياه برغبته في الحديث عن وظائف البيان: أي الأدب، والإتيان إلى أقسامه في اللسان( ): أي الأنواع التي تنحدر منه ، على أن لفظ اللسان في الكتاب ورد بدلالة : اللغة ونتاجها ، ومثاله قوله : ((فاللسان ترجمان اللبّ ، وبريد القلب، والمبين عن الاعتقاد بالصحة والفساد))، وقد أحال على قول للنبيّ محمد(ص) حين سأله ابن عباس : فيم الجمال يا رسول الله فقال : في اللسان( )، والإحالة تكشف عن مقدار عناية (ابن وهب) في فهم الظاهرة اللسانيّة ، والتمسك بأصولها.
في باب (تأليف العبارة)، كان (أبن وهب) قد أسهب في وصف طبيعة الأشكال الأدبيّة المعروفة في زمنه، والعبارة عنده البيان بالقول الذي يختلف باختلاف اللغات، فهو كما يقول الكلاعي (550هـ) ((روح الكلام))( )، من هنا أفهم أنّ العبارة التي عناها (أبن وهب) تعني تأليف القول الشعري ، أو النثري ، الذي يساوي عند غيره الجنس الأدبي ، وتفرعاته الدنيا.
يقول (أبن وهب) وهو بصدد الحديث عن أجناس الأدب عن العرب :((اعلم أنّ سائر العبارة في لسان العرب ، إمّا أن يكون منظوما، أو منثورا، والمنظوم هو الشعر، والمنثور هو الكلام))( )، وبهذا التقسيم يكون قد شمل الأدب العربي بجنسيه المعروفين على أمل أن يسهم في تفريع كل جنس إلى أنواع ، وبحسب التنظيم الآتي:
1- المنظوم:
أراد (ابن وهب) بالمنظوم الشعر، وهو ما شَرُف عند العرب بالوزن والقافية( )، وهو بحسب فهمه كلامٌ مؤلّفٌ ؛ أي مبنيٌّ على وفق نظام ، محصور بالوزن والقافية ، يضيق على صاحبه ، فما حسن منه فهو في الكلام حسن ، وما قبح منه فهو في الكلام قبيح( )، فـ(ابن وهب) في هذا التعريف كان الأقرب إلى تعريف قدامة بن جعفر(337هـ) للشعر: ((قول موزون مقفى يدلُّ على معنى))( )، لولا إشارته الذكيّة فيما بعد تلك التي دلّت على أنّ الشعر لا يتّسع إلى القائلين جميعا ، فهو يضيّق إلا على الشعراء ؛ وأنّ الشعر الحقيقي ليس وزنا فحسب( )، وإنّما هو تجربة تتجاوز الفهم الضيّق للمصطلح ، فكلامه السابق يدلّ على فهم آخر للشعر ، ومعرفة أخرى لأسسه التي لا تقوم على الوزن ، والقافية وحدهما ، وإنّما على تصوير الأحاسيس ، والمشاعر، والانفعالات التي لا يقدر على تصويرها غير الشاعر المبدع( )، وبهذا الرأي تُسجّل (لابن وهب) أسبقيّة في فهم الشعر خارج سلطة الوزن بوصفه فنّا لغويّا يمتلك فرادة في الوعي ، والتنظيم ، وهذا يؤكّد للبحث أنّ معايير الشعر الأساسيّة عند هذا الناقد ليست الوزن ، وإنما اللغة التي تعطي فكرة عن طبيعة الجنس الأدبي.
قسّم (ابن وهب) الشعر على الأنواع الآتية بحسب ترتيبه:
أ- القصيد:
وهو جمع قصيدة: مجموعة من الأبيات الشعريّة ترتبط بوزن واحد من الأوزان العربيّة، وتلتزم فيها قافية واحدة، ولا بد للقصيدة من أن تتألف من سبعة أبيات في الأقل( )، وكان (ابن وهب) قد رأى في القصيد أحسن الشعر ، وأشبهه بمذهبه( )، ولعلّه في لفظ (أحسن) أراد التأكيد على سلسلة المراتب التي يُستنزل فيها الشعر ، بوصفه مذهبا أي جنسا قائما بذاته ذا مرجعيّة تمت إلى ثقافة العرب الأولى.
ب- الرجز:
بحرٌ من بحور الشعر العربي ، ونوعٌ من أنواعه يكون كلّ مصراع منه مفردا، وتسمى قصائده أراجيز، واحدها أرجوزة ، وهي مثل هيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر ، ويسمى قائله راجزا ، وسمي رجزا لأنّه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء واصله مأخوذ من البعير إذا شُدّت إحدى يديه فيبقى على ثلاثة قوائم( )، وكان (ابن وهب) قد رأى في الرجز من أخف الأشعار، وكان في الأصل أن يُرتجز به الساقي على دلوه إذا مدّها ، ثمّ أخذ الشعراء به فلحق بالقصيد( )، من يدقّق في تفصيل الناقد السابق سيتأكّد أنّ الرجز كان عنده بمنزلة أدنى من القصيد بدليل الإحالة إلى أصله النثري ، وموقعه الهامشي ، وقد نقل الباقلاني(403هـ) طبيعة النظرة الدونيّة إلى الرجز حين قال: ((إنّ الرجز ليس بشعر أصلا))( )، فهو بحسب أعراف الكتابة الشعريّة عند العرب ينتمي إلى مرجعية شعبيّة وإن كان من الشعر.
ت-المسمّط:
والمسمّط هو أن يأتي الشاعر بخمسة أبيات على قافية ثم يأتي ببيت على خلاف تلك القافية، ثم يأتي بخمسة من أبيات على قافية أخرى، ثم يعود فيأتي ببيت على قافية البيت الأول إلى آخر الشعر( )، فهذا الشعر عند الناقد (ابن وهب) يحيل على طبيعة لغويّة تستجيب لطبيعة الشكل الشعري الذي يندرج تحت نوع واضح عند النقاد ، فهو في الحقيقة مبنيٌّ على أشطر مقفاة بمرجعيّة صوتيّة سببها تنوّع القافية.
ث-المزدوج:
وهو ما أتى على قافيتين إلى آخر القصيدة، وأكثر ما يأتي على وزن الرجز( )، فهو نوع شعريّ ذو معياريّة صوتيّة تنتمي إلى شكل شعري خاص عرفه العرب.
*
ممّا سبق ذكره يمكن القول مع د. رشيد يحياوي ((إن تصنيف ابن وهب منهجي ؛ لأنّه يضع أنواع الشعر في مكانها حين يقرّ بكونها أقساما له، ولأنه يجعل الشعري في مكانه كمقابل للنثري ، ويجعل الطرفين فرعين لنوع أعلى هو العبارة ، أو اللغة))( )، وأن نسجّل على أنواعه الخاصّة بجنس الشعر الملاحظات الآتية :
1-إنّ (ابن وهب) انطلق من الشكل الأدبي إلى المضمون في ضمن فضاء جنس أدبيّ واحد هو الشعر، في إشارات واضحة على طريق صوغ الشكل النصيّ الذي يندرج تحت فضاء الشعر.
2-لم يعلّق (ابن وهب) على فحوى المصطلحات كثيرا؛ لأنّها كانت معروفة في زمنه.
3-كان (ابن وهب) مبتكرا لهذا التقسيم ، ولم يكن مسبوقا به.
4-لم يذكر (ابن وهب) الموشّح على الرغم من أنّه كان معروفا في زمنه.
أغراض الشعر:
تحدّث ابن وهب عن فنون الشعر التي سمّها (أصنافا) و(فنونا) ، والصنف في اللغة ضَرْبٌ من الشيء متميّز ، بمعنى أنّه أراد الحديث عن فنون من الشعر العربي كثيرة تجمعها في الأصل أصناف أربعة : أي أغراض ، والغرض هو القصد من قول الشعر لهدف يتساوق مع نية الشاعر ، وهي عنده : المديح ، والهجاء، والحكمة، واللهو، ثم تتفرّع عن كلّ صنف من تلك الأصناف فنونٌ فيكون من المديح : المراثي، والافتخار، والشكر، واللطف في المسألة، وغير ذلك ممّا أشبهه، وقارب معناه معناه، ويكون من الهجاء: الذم، والعتب، والاستبطاء، والتأنيب، وما أشبه ذلك، وجانسه، ويكون من الحكمة : الأمثال ، والتزهيد ، والمواعظ ، وما شاكل ذلك ، وكان من نوعه ، ويكون من اللهو : الغزل ، والطرد ، وصفة الخمر، والمجون ، وما أشبه ذلك وقاربه( )، فهو في هذه المقاربة جاء إلى أغراض الشعر وجمعها في أربعة تتفرع إلى أنماط صغرى.
هل كان (ابن وهب) أول من ابتكر الحديث عن أغراض الشعر؟، لقد سُبق بآراء ابن سلام (232هـ) الذي جعل تعدّد الأغراض الشعريّة أحّد معايير وصول الشعراء الى الطبقة العليا في الشعر( )، ومجايله قدامة بن جعفر (337هـ) الذي ردّ أغراض الشعر إلى المدح ، والهجاء( )، لكنّ (ابن وهب) كان أكثر دقّة من سابقيه في تنميط ظاهرة الغرض ، وربطه بالإبداع الشعري .
وكان (ابن وهب) قد رأى أن الشعر الفائق ما اجتمعت فيه : صحّة المقابلة ، وحسن النظم ، وجزالة اللفظ ، واعتدال الوزن ، وإصابة التشبيه ، وجودة التفضيل ، وقلّة التكلّف ، والمشاكلة في المطابقة ، وعيبه في اضداد هذه الصفات التي تجعله ممجوجا في الآذان، خارجا عن وصف البيان( )، فهو في صدد تحديد أبرز المؤثرات في لغة الشعر ، وصوره ، على أنّ وصف الشعر بالفائق هو تأكيد نقدي يستند إلى ذائقة الناقد التي نهلت من أصول البلاغة العربيّة في لسانها المنفتح على جماليّات التشكيل الشعري ، وجاز لها أن تبتكر لخطابها صيغ تقديم الشعر موسوما بالتفوّق أي العلوي منزلة وقبولا.
• الشاعر:
أحال ابن وهب لفظ (الشاعر) على المعجم في محاولة للتعريف به ، فهو من : شعر يشعر شعرا فهو شاعر ، ثم قدّم توصيفا يمكن أن يكون جديدا له بقوله : ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره ، وكلّ من كان خارج هذا الوصف فليس بشاعر وإن أتى بكلام موزون مقفى( )، وكان للشاعر فيما رأى (ابن وهب) الفضل إذا ساوى المتكلم في تجويد المعاني ، وبلاغة اللسان( ).
اعتمد (ابن وهب) في المقاربة السابقة على المعجم للتعريف بمصطلح الشاعر في خطوة منهجيّة لما يزل معمول بها ، وكان فيها سابقا للباقلاني الذي رأى أنّ الشاعر ((يشعر بما لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام ... وذلك أنّ الشاعر يفطن لما لا يفطن له غيره، وإذا قدر على صنعة الشعر كان على ما دونه...أقدر))( )، فضلا عن انّ (ابن وهب) رأى أنّ الشاعر ليس نظّاما فحسب ، إنّما هو صاحب رؤية تتكئ على مجموعة من التشكيلات اللغويّة والجماليّة التي تنتمي إلى مهارة وقف عندها النقد الحديث أيضا ذلك الذي يرى أنّ الشعر ليس بالوزن والقافية فحسب ، إنّما في ممارسة الوظيفة الشعريّة( ).
واسهم (ابن وهب) في إيجاد وظيفة للشعر في الحياة ، فهو ديوان العرب في الجاهلية ؛ المعادل الموضوعي للحياة ، وتحولاتها ، وقد حفظ مآثر الآباء وأخبارهم ، وما مضى من أيامهم ، ووقائعهم ، ومستحسن أفعالهم ، ومكارمهم ، فلولا الشعر ما عَرَف جود حاتم ، وكعب بن مامة ، وهرم بن سنان ، وأولاد جفنة، وما عرفت بطولة شجعانهم ، وشهر في الناس ذكرهم ، وعناؤهم ، وآثارهم في مواقعهم( )، والحديث عن وظيفة الشعر في النقد العربي القديم يستدعي الوقوف عند الشعر بوصفه نشاطا ثقافيّا له سلطة المركز الجامع لأصول التقاليد ومدياتها الضاربة في العمق ، النافذة إلى الوعي ، فهو يستحوذ على الذائقة العربيّة منذ زمن ليس بالقليل ، وبه عُرف العرب ، فكان ديوانهم الذي إليه ينتسبون.
وكان (ابن وهب) قد تحدّث عن ثقافة الشاعر ، فهو يحتاج إلى تعلّم العروض ؛ ليكون عيارا له على قوله ، وميزانا على ظنّه ، فضلا عن احتياجه النحو ليصلح به لسانه ، ويقيم به إعرابه ، والنسب ، وأيام العرب ، والناس ليعرف المناقب ، والمثالب للإفادة منهما في المدح والهجاء، وأن يروي الشعر ليعرف مسالك الشعراء، ومذاهبهم، وتصرفهم ليحتذي بهم ، ويسلك سبيلهم( ).
وتحدّث (ابن وهب) عمّا يجوز للشاعر من قصر الممدود، وحذف الحركة، وتخفيف الهمزة، وصرف ما لا ينصرف ، ما لم يجزه للمتكلم ، فضلا عن الإجازة في الوزن استعمال الزحاف والخرم ، وفي القافية الاكفاء ، والاقواء، والسناد، والايطاء، والتضمين، ، فهي عيوب ، وعلى من استعمل البديهة ، وقال الشعر على الهاجس ، والسجية أقلّ عيبا منها على من استعمل الروية والتفكير، وكرّر النظر والتدبر( )، فهو في تجويزه كان باحثا عن رخص تتساهل في لغة الشاعر تلك التي تنتمي إلى أصول صارت فيما بعد تقاليد يقف عندها الشعراء تعنى ببناء القصيدة عند العرب في نصّها الشكلي الذي يقوم على لغة منضبطة العبارات ، والقياسات ، وصولا إلى تقديم شعر مميّز في تراكيبه ، وتماسكه النصيّ ، وصوره ، وموسيقاه ، وأفكاره ، فضلا عن جودة العاطفة .
وألزم (ابن وهب) الشاعر فيما يقول من شعر بأن لا يخرج في وصف أحد ممّن يرغب اليه ، أو يرهب منه ، أو يهجوه ، أو يمدحه ، أو يغازله عن المعنى الذي يليق به ويشاكله ، فلا يمدح الكاتب بالشجاعة ، ولا الفقيه بالكتابة ، ولا الأمير بغير حسن السياسة ، ولا يخاطب النساء بغير خطابهن ، ، وله أن يمدح كلّ أحد بصناعته ، وبما فيه ، من فضيلته ، ويهجوه برذيلته ، ومذموم خليقته، وأن يغازل النساء ، بما يحسن من وصفهن ، ومداعبتهن ، والشكوى إليهن ، ثم حذر الشاعر من مفارقة هذه السبل( ).
والزم (ابن وهب) الشاعر في جملة وصاياه : أن يتقصّد في الوصف ، أو التشبيه ، أو المدح أو الذم ، وله أن يبالغ ، وأن يسرف حتى يناسب قوله المحال ويضاهيه، فهما بحسب رأيه يليقان بالشعر( )، والالزام هنا فنيّ خاص معنيّ بطريقة تقديم الشعر.
ورأى أنّ ممّا يزيد من حسن الشعر ، ويمكّن من طلاوته حسن الإنشاد، وحلاوة النغمة ، ومشاكلة اللفظ إلى المعنى( )، فهو إزاء خطوة أخرى تقتفي الظاهرة الصوتيّة المرافقة لتقديم الشعر ، فقد تنبه (ابن وهب) إلى المعيارية الصوتية للشعر من خلال ادراكه الضمني لأهم المصطلحات ، والظواهر الصوتيّة مثل : البحور الشعريّة ، والقوافي ، والتكرار، والسجع ، والجناس ، والتقطيع ، فالنصّ العربيّ قديمه ، وحديثه متضمن للصوت سواء أكان نثرا، أم شعرا، وبدرجات متفاوتة يمكن مسكها ضمن أطر إيقاعية تشكّل مع بعضها دلالة صوتيّة اصطلح على تسميتها في العصر الحديث بـ((الأسلوبيّة الصوتيّة))( )، وهي تعني بحسب رأي (بيير جيرو) بتحليل المتغيرات المسموعة أسلوبيّا بالإحالة على اللغة بوصفها نسقا كاملاً من المتغيرات الأسلوبيّة الصوتيّة يمكن للدارس الأسلوبي أن يميّز من بينها النبر، والمد ، والتكرار ، والمحاكاة الصوتيّة ، والجناس ، والتناغم( )، وغيرها من المصطلحات.
2-المنثور:
المنثور الجنس القسيم للمنظوم عند العرب، وقد جاء في لسانهم ((نَثَرَ الشيءَ ينثُرُهُ ويَنْثِره نثرا ونثارا: رماه متفرقا))( )، وهو عند (ابن وهب) الكلام الأدبي المبني من منثور الكلام فهو مطلق غير محصور ، يتّسع لقائله( )، في إشارة إلى عدم تقييد الكتابة للناثر، واتساع مظاهر الإبداع فيها ، وقد قسّمه على الأنواع الأدبيّة الآتيّة:
أ- الخطب:
وهي عند (ابن وهب الكاتب) مأخوذة من خَطَبتُ أخْطُبُ خطابة ، والخطابة ، والخطاب اشتقا من الخطب والمخاطبة؛ لأنهما مسموعان( )، والخطبة تستعمل في اصلاح ذات البين ، وإطفاء نار الحروب ، وحمالة الدماء، والتسديد للملك ، والتأكيد للعهد، وفي عقد الأملاك، وفي الدعاء الى الله، -عزّ وجل- وفي الإشادة والمناقب ، ولكلّ ما أريد به ذكره ، ونشره ، وشهرته في الناس ، وقد تحدّث (ابن وهب) عن الخطابة في دورها الشفاهي التي كانت فيه مسموعة من قائلها ، ومأخوذة من لفظ مؤلفها ، وكان الناس جميعا يرمقون الخطيب ، ويتصفّحون وجهه ، وكان الخطأ فيها غير مأمون ، والحصر عند القيام بها مخوفا محذورا؛ ولهذا صار الخطيب بلاغيّا أفضل من المترسل( )، ثمّ جرى توثيقها شأنّها شأن الشعر ، وغيره من أدب العرب ، ممّا سبق يتبين أن الخطبة تنتمي إلى مرجعيّة اجتماعيّة صنعتها الحاجة ، وقدّمتها الموهبة.
ومن معايير بناء الخطابة عند (ابن وهب الكاتب) : أن تفتتح بالتحميد، والتمجيد وتوشح بالقرآن الكريم، والمثل السائر؛ لأن ذلك يزين الخطبة ، ويجعلها أعظم فائدة ، محاشاة لأن تكون الخطبة بتراء او شوهاء، ورأى أن الخطب الطوال لا يتمثل فيها بالشعر، بخلاف الخطب القصار، والرسائل( ).
لقد أجاز (ابن وهب) للخطب القصار، والرسائل أن تتلوّن سياقاتها بالشعر الذي يؤدّي وجوده إلى عذوبة تصويت ، ودلالة يتوسّل بها النثر فتطاوعه لتشكّل فيما أرى (حالة شعر) في الخطبة القائمة على الإيجاز الذي هو عند العرب بلاغة أيضا ، بخلاف الخطب الطوال التي أوجب (ابن وهب) على لغتها أن تكون أقرب إلى لغة الحقائق ؛ لأنّها تتوجّه إلى متلقين للسياسة ، أو الصلاة فحسب.
وممّا يزيد في حسن الخطابة ، وجلال موقعها في نفس المتلقي عند (ابن وهب) جهارة الصوت ( )، فقد تنبّه إلى أهميّة صوت الخطيب الذي يتناغم مع مقاصده، ويكاشف عن أغراضه ، ومصاحبته للألفاظ إذا كان الإلقاء جيّدا بمنزلة بيان المعاني التي أرادها الخطيب ، وهو المُعَوَّل عليه في إيصال الخطبة إلى السامعين ، ومِنْ ثم إلى قلوبهم، وقد سمّاه الأقدمون : نورا ؛ لأنه يحمل شعلة الضياء إلى الأذهان( )، فضلا عن قدرة الخطيب على الايجاز في مخاطبة الخاصة وذوي الافهام الثاقبة ، وفي المواعظ والسنن ، والاطالة في موضع مخاطبة عوام الناس( )، مراعيا أحوال الناس ومقاماتهم.
ب- الترسل:
يريد (ابن وهب) بالترسل كتابة الرسائل التي تدبّج للاحتجاج على من زاغ من أهل الأطراف، وذكر الفتوح، وفي الاعتذارات، والمعاتبات، وغير ذلك( )، فهي نوع من الأدب القديم الذي ينتمي إلى مرجعيّة سياسيّة لكنّها -الرسائل- صارت فيما بعد منفتحة على أشكال تجاوزت ما هو سياسي : إداري إلى ما هو عام وخاص.
وكان القلقشندي (821هـ) قد عرّف الرسائل بأنّها ((جمع رسالة ، والمراد فيها أمور يرتبها الكاتب من حكاية حال من عدو، أو صيد ، أو مدح وتقريض، أو مفاخرة، بين شيئين، أو غير ذلك مما يجري في هذا المجرى))( )، والرسائلُ يجهد الإنسان بحسب رأي (ابن وهب) في تحكيكها ، وتكريرها ، والنظر فيها ، وإصلاح خلل إن وجد في شيء منها ، فهي نافذة على يد الرسول ، أو في طي الكتاب( )، فهو يريد التأكيد على أنّها مدوّنة نصوصيّة كفي صاحبها رمق العيون ، وتصفح الوجه ، والخطأ فيها مأمون ، والحصر عند القيام بها غير مخوف ولا محذور( )، ورأى أن لا تكون الرسالة إلى الخليفة محلاة بالشعر ، فإنّ محلّه يرتفع من التمثل به، وأن يكون المترسل عارفا بمواقع القول ، وأوقاته واحتمال المخاطبين ، وأن لا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصّر عن بلوغ الإرادة ، ولا الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز في مقدار الحاجة إلى الضجر والملل ، وأن لا يستعمل الفاظ الخاصّة في المخاطبة ، ولا كلام الملوك مع السوقة بل يعطي لكلّ قوم مقدار حالهم( ).
إنّ ما ورد في السياقات السابقة الخاصّة بطبيعة الخطابة ، الرسالة ليس بالأمر القديم فحسب ، إنّما هو بعض ما تنادي به اللسانيّات التداوليّة الآن، وهي تلاحق وجود الخطابات ضمن طبيعة التعاون بين المخاطِبين، والمخاطَبين لإنجاز أفعال الكلام ، وهذا الطرح يلتقي والنظريّة السياقية لـ(فيرث) الذي أكّد الوظيفة الاجتماعيّة للّغة، فهو يرى أنّ سياق الموقف واسع، وأنّ الكلام ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة مواقف، وقد عمل من أجل إظهار قيمة المقام، و الأثر الذي يشكّله في شرح المعنى و تفسيره، و هذا ما تعمّق في فكر طلبته وعلى رأسهم (هاليداي) الذي يقول : ليس هناك انفصال بين ماذا نقول ، و كيف نقول، فاللغة إنّما تكون لغة عن طريق الاستعمال في سياق الحال ، و عدّ المقام البيئة التي تجعل الحياة تدبّ في النص، كما انتهى (فان دايك) إلى أنّ المقام يجعل من التركيب غير ذي المعنى تركيبا ذا معنى( )، .
والرسائل عند (ابن وهب) مستغنية عن جهارة الصوت ، وسلامة اللسان من العيوب ؛ لأنّها تكتب بالخط ، ولكن بشرط سلامة نصّها المكتوب ، ولا تلقى فتحتاج إلى القراءة ويساعد حسن خطها على تلقيها الذي يزيد من بهائها ، ويقربها من قلب متلقيها( )، بمعنى أنّ جمال الخط في الرسائل يسهم في تلقيها بوصفه عتبة بَصَريّة تمارس هيمنة على وعي المتلقي ، كما يمارس جمال الصوت هيمنة على تلقي الخطبة.
ت-الاحتجاج:
أراد (ابن وهب) بالاحتجاج الجدل والمجادلة، أو المناظرات على أهل الأطراف ، وذكر الفتوح، وفي الاعتذارات، والمعاتبات، وغير ذلك ممّا يجري في الرسائل والمكاتبات( )، وقد عرّف الجدل بقوله: ((قول يقصد به إقامة الحجة فيما أختلف فيه اعتقاد المتجادلين ... ويدخل في الشعر والنثر))( )، ولعلّ (ابن وهب) عنى بالاحتجاج في هذا السياق أساليب الجدل ، والمجادلة التي تتوشّح بها الخطابات الأدبيّة ، فليس الجدل نوعا أدبيّا قائما بذاته إنّما هو مهاره بلاغيّة أدخله الناقد في ما يجري في العبارة بقصد تقوية المحادثة ، ووضعها في موضع الحجّة عند المتخاصمين ، ودليلي أنّه قال إنّ الجدل يجري في الرسائل والمكاتبات ، بمعنى أنّه يتخلل في سياقاتها.
ج-الحديث:
تحدّث (ابن وهب) عند الحديث الذي ((يجري من الناس في مخاطباتهم ، ومجالسهم ، ومناقلاتهم))( ) ، وهو عنده أدبٌ قائمٌ على اتقاء الخطأ، والزلل، واللحن ، والخطل، سالم من هجنة معايب القول ، قائم على تحديد مقدار القول بلا فضلة ، ومقدار نشاط المستمع( )، ويرى (طه حسين) أنّ الأحاديث الاعتياديّة ، ومنها لغة التخاطب لا تعني درس الأدب العربي وتأريخه ؛ لأنّ قيمتها لا تظهر إلا حينما يكون لها حظٌ خاصٌّ من الجمال( )، ويبدو أن الذائقة النقديّة القديمة كانت تقبل تلك الاحاديث لصلتها بالمناظرات والمسامرات ، فهي ليست اعتياديّة بل أدبيّة بدليل الشروط الفنيّة التي وضعها (ابن وهب) في كلامه السابق.
ح – الوصايا:
والوصايا لونٌ من الأدب الذي يمتاز بالإيجاز، والفصاحة، ينفتح على جملة من التجارب الحياتيّة التي يقدّمها صاحب الوصيّة إلى الموصى إليه تتعلق بطرائق الحياة، وسبل أمن إشكالاتها، وفي أدبها((توجيه أو إبلاغ))( )، وقد جاء على ذكر نماذج منها( )، من دون أن يعمد إلى تعريفها ، وتحليل أبرز مزاياها اعتقاد منه بهامشيّتها قياسا بالخطابة ليس غير.
خ- التوقيعات:
التوقيعات ((الكتابة على الرقاع ، والقصص بما يعتمده الكاتب من أمر الولايات ، والمكاتبات في الأمور المتعلقة بالمملكة ، والتحدّث في المظالم))( )، وقد تعامل معها (ابن وهب) تعاملا ينمّ عن عدم الاهتمام التنظيري في طبيعة صوغها ، وبنائها ؛ ربّما اعتقادا منه بكونها أدبا نخبويّا لا يمارسه إلا عليّة القوم من الخلفاء، والوزراء( )، ويشير بناء نصّ التوقيعات إلى أدبيّة مؤلفها ، فقد عدّت أدبا قائما بذاته مبنيّا على الإيجاز ، وحضور البلاغة التي تعد ايجازا أيضا ، أما إذا كانت التوقيعات منوطة بكاتب يتم الإيعاز له بالكتابة فإنّها والحال هذه تستدعي البلاغة والفصاحة أيضا؛ لأنّ نصّ التوقيعة يشير إلى الخليفة أو الأمير، لكنّ كاتب التوقيع ((يأخذ الفكرة المراد توصيلها ، فيكسوها من لحم الفاظه، فيستدعي ذاكرته وخزائن محفوظاته ليستعين بها على الصياغة ثم يشرع بالخط))( )، فيولد التوقيع.
د- الأمثال:
على الرغم من أن (ابن وهب) تحدّث عن الأمثال خارج منظومة (العبارة في لسان العرب) إلا أنّه عدّها نوعا من القول يضرب به الحكماء، والعلماء، والأدباء، الأمثال ويبيّنون للناس تصرف الأحوال بالنظائر ، والأشباه ، والأشكال ، فهو أنجح مطلبا، وأقرب مذهبا ، ودليله ذكره في القرآن الكريم( ).
إنّ النثر القديم بوصفه جنسا يحال على أنواع أدبيّة تنتمي إلى متون تنتظم في نصوصها مجموعة سمات تركيبيّة ، وفنيّة ، وموضوعيّة تتقولب في شكل خطابيّ مفارق لغيره من خطابات الشعر المعروف منها : المثل الذي يمتلك مزايا نصيّة لا يمكن أن تتواجد في أنواع أدبيّة أخرى منها: السرد، والايجاز، والمفارقة ، فالأمثال بالضرورة تتبع جنسا أعلى هو النثر ، فهو بتشكيله الأدبي فرض سلطته الجماليّة ، والدلاليّة قديما ليكون نوعا أدبيّا متّصلا بالأدب واللغة ، وللأمثال حضور ثابت في نظام الأجناس الأدبيّة العربيّة ترتّب عليه ، أو تسبّب فيه ما حظيت به من احتفاء اعتباري ،وعناية معرفية( ).
*
لم يتكئ (ابن وهب) على ناقد سابق ، فهو في تفريعاته النثريّة مارّة الذكر ، وإنّما كان مبتدعا للتقسيم، والإضافة أيضا، فقد رأى أن لكلّ واحد منها موضع يستعمل به( )، في إشارة إلى استقلاليّة النوع الأدبي عن جنسه، وواقع الأمر يحيل على أنّ تقصي (ابن وهب) لقضيّة الأجناس الأدبيّة عند العرب هو الأقرب إلى التحديد الصحيح؛ لأنّه قرأ الأدب في يومه ذاك، وجاء بتقسيماته المتطابقة مع واقعه المعلن، من دون أن يعتمد على مقولات السابقين مع أنه لم يتطرق إلى أنواع أدبية أخرى مثل: الحكاية، والنادرة، والاخبار، لكنّ د.أحمد محمد ويس يرى أنّ :((تصنيف ابن وهب هو أدنى التصنيفات الى الكمال، وإن كنا نأخذ عليه إغفاله بعض الأنواع، وكذا إغفاله بيان موقع القرآن من أجناس الكلام المعروفة إذ ذاك))( ).
ولي على التوصيف السابق ردّ مؤداه أن تصنيف (ابن وهب) كان متقدما بدليل اشتماله على أكبر عدد من الأنواع الأدبيّة التي لم يقف عنها ناقد سابق له، أما إغفاله بيان موقع القرآن من أجناس الكلام المعروفة يوم ذاك فهو ليس اغفالا بل تعمدا، بمعنى أنّ (ابن وهب) أخرج القرآن الكريم من تقسيمات الأدب يوم ذاك ، وهو عين ما فعله الجاحظ (255هـ) الذي رأى أنّ : أقسام تأليف جميع الكلام تنقسم على : كلام موزون أراد به الشعر، وكلام منثور أراد به الخطب ، والرسائل وغيرهما، وكلام منثور غير مقفى على مخارج الأشعار، والأسجاع أراد به القرآن الكريم( ).
ويرى د. رشيد يحياوي أنّ تصنيف (ابن وهب) الانتقائي لا يغامر بنزعة إحصائيّة ، بل يترك تصنيفه مفتوحاً بدليل قوله : (منها) ، مما يعني أنّه لن يقيم تصنيفه إلا على بعض النماذج التي يظهر أنه انتقى المعروف منها، حيث بدأ بالقصيد، ثم أعقبه بالرجز، فالمسمط، والمزدوج، معتمدا عنصري الوزن، والقافية للتمييز بينها( )، لعلّ (د.يحياوي) تأوّل لفظ (منها) بالإحالة على رؤية مستقبلية ، وهو تأويل صحيح.
لقد اجتهد (ابن وهب) في مسألة كان القول فيها يوم ذاك لا يتأتى إلا لذوي الفكر النيّر، والعقل المنفتح على التطورات التي تصيب شكل الأدب، وتمتد الى مضامينه أيضاً، فليس من اليسر على ناقد قديم أن يتملى الشكل الأدبي ليعبّر عن عناية مخصوصة بالشعر، والنثر بوصفهما جنسي العبارة الأدبيّة، ثم يربط الشعر بمضامينه التي هي أغراض الشعر الكبرى، أو صنوفه بحسب تسميته، ليدل على ما يخرج منها من فنون.
إنّ المقولات الأجناسيّة العربيّة التي ظهرت عند (ابن وهب) تشكّل اليوم خطابا نقديّا يمكن الوقوف عند عتباته المفضية إلى قراءة نمط من التفكير الذي لا يمكن إهماله ،أو القفز على منجزه ، مهما كانت درجة تشخيصه النقدي ، بل يمكن التدقيق في طبيعة تشكّله اللسانيّ الذي يحيل على مجموعة أفكار يُنظر إليها –اليوم- على أنها جزء من خطاب يمكن اخضاعه إلى التحليل والتأويل.
(خطاطة ابن وهب)
في الشعريّة:
رأى ابن وهب الكاتب أن القول النثري يتساوى والشعر ؛ لأن البلاغة تقع في كليهما، ومما تساوى القول والشعر فيه قول بعضهم : فكانت معاقلة تعقله ، وما يحرزه يبرزه( )، ففي النصين الموجزين السابقين سمة أساسيّة مأخوذة من الشعر لكنها - وهذا سرّ فاعليّتها- موجودة في النثر، تلك التي تتعلّق بقدرة اللغة على الانزياح ، والاسناد خارج منظومة الحقائق ، بمعنى أدق أنّ موضوع الشعريّة هو قبل كلّ شيء الإجابة عن السؤال الآتي)) :ما الذي يجعل من رسالة لفظيّة أثرا فنّيّا؟))( )، ورأى (ابن وهب) أن الشعر يتمثل في الخطب القصار، وفي المواعظ، والرسائل( )، وهذا يعني أنّه أباح دخول اللمسات الجماليّة التي تتحكّم في الخطاب الأدبي ليكون مدار فاعليتها صوت الشعر.
التداخل الأجناسي:
ورأى أن الشعر يستعمل في الخطابة ، والرسائل( )، بمعنى أن لغة الشعر تدخل في بناء الخطب ، والرسائل ليكون التداخل بينه وبينهما يعطي فكرة عن تمازج لونين من الكتابة الإبداعيّة سببها أنّ الأديب كان قد وقع تحت هيمنة جنس الشعر، فهو لا يقوى على مقاومة إغوائه ، ولا يقدر على مفارقة النثر، وهذا ما دعاه إلى القفز فوق (الحدود) التي وضعت لكلا الجنسين، ليرفض المعايير التي تأبى اجتماعهما في نص واحد ، فالنصّ الجديد ذو الشكليّة الشعريّة يستند إلى معيار جامع هو معيار (الكتابة)، و بديهي أنّ تداخل أنماط الكتابة يمهد لحدوث تقارب بين الأجناس، فإن نحا الشعر نحو النثر، وإن نزع النثر نحو مشاكلة الشعر فهذا يعني ظهور جملة من الأجناس الواقعة في حيّز بين حيّزين، أو في منزلة بين منزلتي الشعر، والنثر، أي أجناس هجينة بحسب عبارة (باختين) التي تصلح هنا ، كما أنّ امتداد ظل النثر على مجال الشعر، أو انتشار ظل الشعر على مجال النثر، وما ينجر عنه من تماس بين مجاليهما لا بد أن يتخذ له شكلا، وأن تكون بعض الأجناس أداة لتجليه( )، وهذا ما يتوضح في الخطب ، والرسائل التي تقوم لغتها على شعريّة واضحة ، وأسلوب مفارق لطبيعة الكلام الاعتيادي.
الخاتمة:
1- كان (ابن وهب) قد أدرك أهميّة التفصيل في أنواع الأدب العربي انطلاقا من الخصائص الجماليّة التي تحلى بها كلّ نوع ؛ ولهذا أسهب في التفريق بين نوع وآخر استنادا إلى معرفته الخاصّة ، وما وصله من زاد معرفيّ استعان به في التحليل ، ولا سيّما ما وصله من الجاحظ ، وأبي هلال العسكري.
2- قسّم (ابن وهب) الشعر على أنواع أربعة ، وهو تقسيم يحسب له غير مسبوق به ، وقد ربط بين النوع الشعري، والغرض في مهمّة اوجدت لقاء يجمع الشكل بالمعنى.
3- أما تقسيم النثر فقد أجاد (ابن وهب) في التفصيل به ، والاتيان بأنواع جديدة لم يتجرّأ ناقد سابق له على الإتيان بها مثل : الأمثال ، والتوقيعات.
4- وكان لـ(ابن وهب) فضل الحديث عن تداخل الشعر بالنثر ، وهو ما يسمى اليوم بالتداخل الأجناسي حين لاحظ تداخل الشعر مع الخطابة ، والرسائل ، بمعنى أنه لاحظ لغة الشعر وهي تدخل في بناء الخطب ، والرسائل ليكون التداخل نوعا من التمازج بين لونين من الكتابة الإبداعيّة التي تبيح وجود الشعر في النثر بوصف الاباحة تنظيما شفيفا لأعلى درجات صوغ الخطاب المنطلق من الذات المقرون بتخيّل هدفه تشكيل النصّ تشكيلا مغايرا يراعى فيه ابتكار لغة تتساوق وجمال الشعور النفسي.
الإحالات:
المصادر والمراجع:
1- الاتجاهات الأدبيّة في القرن العشرين: البيريس : ترجمة جورج طرابيشي : بيروت : 1965.
2- اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري :د. أحمد مطلوب: وكالة المطبوعات الكويت .
3- إحكام صنعة الكلام :الكلاعي: تحقيق محمد رضوان الداية: دار الثقافة بيروت1966.
4- الأدب العربي القديم ونظريّة الأجناس القصص: فرج بن رمضان: دار محمد علي الحامي: صفاقس: تونس: 2001.
5- الأسلوب والأسلوبية: جيرو : ترجمة منذر العياشي : مركز الإنماء القومي: بيروت.
6- إعجاز القرآن : الباقلاني: : تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر:1963.
7- البئر والعسل قراءات معاصرة في نصوص تراثية: حاتم الصكر: دار الشؤون الثقافية: بغداد: 1992.
8- البرهان في وجوه البيان ابن وهب الكاتب تحقيق د احمد مطلوب ود خديجة الحديثي ساعدت جامعة بغداد على طبعه ط1967:1.
9- البيان والتبيين : الجاحظ: تحقيق عبد السلام محمد هارون: الناشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى في بغداد ط1960.7.
10- تأصيل النظريّات اللسانيّة الحديثة في التراث اللغوي عند العرب: د. هدى صلاح رشيد: دار الأمان : الرباط: 2015: 293، 294، 302، 303.
11- التفاعل في الأجناس الأدبيّة : بسمة عروس : الانتشار العربي : ط1: 2010.
12- ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي :بحث في المشاكلة والاختلاف:د.احمد محمد ويس: منشورات وزارة الثقافة سورية2002.
13- القاموس المحيط: الفيروز آبادي: مؤسسة الرسالة بيروت: ط1: 1986.
14- قضايا الشعريّة : :رومان جاكبسون : ترجمة محمد الولي :ومبارك حنون :دار توبقال :1988.
15- الشعريّة العربيّة: الأنواع والأغراض : د. رشيد يحياوي: أفريقيا الشرق : ط1: 1991 .
16- صبح الاعشى في صناعة الإنشا : القلقشندي: الطبعة الأميريّة : مصر.
17- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي: تحقيقي : محمود محمد شاكر: مطبعة المدني : القاهرة: 1.
18- معجم النقد العربي القديم: د.أحمد مطلوب:ج2:دار الشؤون الثقافية العامّة : بغداد: 1989
19- من حديث الشعر والنثر: طه حسين : دار المعارف بمصر: 1965.
20- نقد الشعر: قدامة بن جعفر: تحقيق: كمال مصطفى: مكتبة الخانجي بالقاهرة ط3 .
- المعرض الدائم في بابل / كلية الفنون الجميلة في بابل
- المعرض الدائم في واسط / جامعة واسط
- المعرض الدائم في كربلاء / البيت الثقافي في كربلاء
- المعرض الدائم في البصرة / البيت الثقافي في البصرة
- المعرض الدائم في تكريت / جامعة تكريت
- المعرض الدائم في الفلوجة / البيت الثقافي في الفلوجة
- المعرض الدار الدائم في الديوانية
- المعرض الدار الدائم في ذي قار
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()